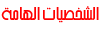مع الإمام محمد عبده، سينحو الوعي العربي الحديث بإشكالية تقدم الغرب في ميدان العلم والتكنولوجيا والتفكير العلمي منحى مغايرا، هذا المنحى سيوجهه سؤال التأخر/النهضة حيث يكتشف بالتجربة العيانية، أن الفرق ليس كميا، وأن الحل ليس تقنيا، بل الحل يكمن في استنهاض روح الامة وعقلها من وهاد ظلمات القرون الثقافية والحفر في طبقاتها المعرفية من أجل تحررها من التأخر. فبعد تجربته العلمية المريرة، مع الازهر، والصحافة، والثورة العرابية، وسلطة القصر، وسماكة الواقع، وفقدانه للشفافية، والقدرة على الاستجابة لطموحات المثقف وحلمه في التغيير والتقدم والعلم، سيؤسس الإمام لنموذج المثقف العربي السيزيفي، حيث الانتحار أمام صخرة السياسة، لأنها "إن شئت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو العلم أو الدين فأنا معك من الشاهدين. أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة… ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس !"( محمد عبده، الإسلام والنصرانية، عن عباس محمود العقاد، محمد عبده، ص164.) وليتحول مشروعه من الفعل في الواقع المباشر، إلى الفعل في العقل، فإدخال برامج العلم في الأزهر، والتعلق بإمكانية امتلاك النموذج التقني للغرب، لم يسفر عن إحكام الحصون "وسد الثغور"، بل لم يسفر إلا عن جدع أنف الأمة، لأن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفاجأتهم قبل أوانها، فلم يكن أمامه سوى تهيئة الأمة لتلك العلوم، فبدون المرحلة العقلانية التنويرية لن يكون العلم سوى جدع لأنف الأمة، حيث العودة إلى القاعدة التاريخية (العقلانية-العلم-الصناعة).
ولهذا سيغدو العلم، بدءا من هذه اللحظة معادلا للحرية، حرية الوطن، حيث " لا وطن إلا مع الحرية" (- محمد عبده، مذكرات الإمام محمد عبده، سيرة ذاتية، عرض وتحقيق وتعليق طاهر الطناحي (كتاب الهلال، العدد705،1992)راجع مفهومه للوطن، ص13-14)، حرية العقل لـ"تحرير الفكر من قيد التقليد"، حرية اللسان، لتحرير اللغة من قيودها المكبلة لطلاقة العقل والفكر، وذلك من خلال "إصلاح أساليب اللغة العربية" وتحريرها من رثاثة المخاطبات الرسمية، "لغة السلطة" وبلادة وبرودة السجع للمثقف التقليدي، "لغة الأدباء والمشايخ" (المصدر السابق، ص26-27.). وأخيرا حرية الفعل وحرية الممارسة المدنية والحضارية، عندما يتيح له موقعه كمفتٍ، أن يطلق فتواه الشهيرة التي سميت باسم فتوى "الترانسفال" والتي شغلت صحافة مصر وصحافة العالم العربي والإسلامي، والتي فحواها، أن الشيخ المفتي "أباح للمسلم أن يلبس القبعة وأن يأكل من طعام أهل الكتاب، وأن يؤدي الصلاة وراء كل إمام يدين بالإسلام." (العقاد، محمد عبده، مصدر سبق ذكره، ص 211.). هذه الفتوى التي شغلت العالم الإسلامي، كان أول من تصدى لها القصر، والخديوي عباس الثاني، الذي سخر الصحافة والأقلام لشن حملة شعواء على الفتوى، بلغت ضراوة هذه الحملة أن لفقت صورة للمفتي في حلبة الرقص، وهو يخاصر فتاة إفرنجية و****ها يعبث بأطراف جبته .
عباس محمود العقاد يعزو هذه الحملة إلى ضغائن الخديوي عباس على المفتي لأنه حال دون الخديوي وأطماعه الشرهة بأراضي الأوقاف، لا ما هو مباح لهم جميعا، فقد كانوا جميعا يلبسون القبعات ويأكلون في المطاعم الأوروبية وفي بيوت الأجانب، ومن يشهد منهم صلوات الجمع فإنما كان يشهدها مع مئات من المسلمين من أتباع المذاهب الاربعة. (المصدر نفسه، راجع ص 211-213.).
لا شك أن هذا التعليل يفسر تلك العداوة بين الخديوي والإمام، لكن أن تبلغ ضراوة حقد الخديوي على الإمام حتى بعد موته، درجة تأنيب موظفه الكبير أحمد شفيق باشا على المشي في جنازة المفتي، بقوله " يظهر – والله أعلم- أنكم أردتم بالسير وراء نعشه المجاملة بعد الموت وهو على ما تعهدونه عدو الله وعدو النبي وعدو الدين وعدو الأمير وعدو العلماء وعدو المسلمين وعدو أهله، بل وعدو نفسه، فلم هذه المجاملة…" (أحمد شفيق باشا، مذكراتي في نصف قرن، عن نفس المصدر السابق، ص 219 ).
هذه الضراوة في الحقد، حيث تتكرر مفردة "عدو" بهذا الإصرار والصرير على الأسنان، لا يمكن التماس تعليلها بالأحقاد الشخصية فحسب، بل هي أحقاد السلطة على المعرفة، على العلم والثقافة حين تندرج في إطار مشروع نهضوي تنويري يهدد امتيازاتها الاستبدادية والظلامية . ذلك ما سيستخلصه الكواكبي، عن الحرب الدائمة بين المعرفة والسلطة، العلم والاستبداد في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، حيث يكتب: "إن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة، وطرادا مستمرا، يسعى العلماء في نشر العلم، ويجتهد المستبد في إطفاء نوره والطرفان يتجاذبان العوام". فالمستبد حسب -الكواكبي- يكره العلم لذاته، ولا يريد أن يرى وجه عالم ذكي "لأن ذلك يشعره بضعته أمامه، وإذا اختار العلماء، اختار منهم المتملقين والمتصاغرين، لأن المستبد عدو الحرية كما هو عدو العلم، وعلوم الحياة"، وليس علوم اللغة والدين والعلوم الصناعية المحضة، ولهذا شجعوا الدين وبعض الفرق الصوفية مثلا فعلوا ذلك بقصد الاستعانة بالدين أو بأهل الدين على ظلم المساكين.
هكذا، مع الإمام "عبده" ورعيله (الافغاني-الكواكبي- عبد الله النديم- فرح أنطون- شبلي شميل- المراش- أديب إسحق…إلخ) سيتحول الفكر العلمي من مشروع برنامجي متفائل ممكن الإنجاز في خطاب الطهطاوي وعلي مبارك وخير الدين التونسي، إلى خطاب مأزوم في خطاب عبده ورعيله، ثم إلى خطاب إشكالي ينضوي تحت العنوان العريض "النهضة" في مواجهة التأخر، حيث سيبرز الاستبداد بوصفه الحلقة المركزية التي توجه الخطاب النهضوي في تعدد أصواته، الإصلاحية الإسلامية، أو الليبرالية العلمانية، بل وحتى للمثقف التقني الذي يراهن على العلم بوصفه العنوان الوحيد للتقدم لدى المثقف القومي والوطني والمسيحي (شميل- أنطون- مراش- إسحق- بطرس البستاني). لقد تحول التفكير العلمي لدى هذا الرعيل، والرعيل الثاني (أحمد لطفي السيد- طه حسين- أحمد أمين- هيكل- العقاد- علي عبد الرازق- بل وحتى لدى النموذج المثقف التقني، الداعية إسماعيل مظهر وسلامة موسى) إلى مقصد من مقاصد النهضة، وليس المقصد الوحيد. بل سيغدو على الأغلب معادلا لـ"العقلانية" كتمثل نهاجي في الممارسة المعرفية للجيل الثاني، حيث سيتمظهر منهجا من مناهج البحث النظري، في قضايا الفكر والفلسفة والآداب والتاريخ ليحقق بذلك الجيل الثاني خطوة على طريق تمثله في ميدان العلوم النظرية والإنسانية، بعد أن كان إشكالية من إشكاليات النهضة لدى الجيل الأول، وعنصرا من عناصر المواجهة مع الاستبداد. فالكواكبي يفرد له فصل "الاستبداد والعلم"، تماما بالدرجة نفسها التي يفرد له فصول (الاستبداد والعوام-الاستبداد والمجد- الاستبداد والدين- الاستبداد والأخلاق- الاستبداد والترف- الاستبداد والمال- الاستبداد والتربية).
يغدو العلم ساحة واحدة من ساحات ضحايا الاستبداد الأخرى، والذي لا يمكن صرعه إلا بتحرير الساحات جميعا، وذلك عبر النهضة الشاملة لكيان المجتمع برمته من تأخره الشامل لكل عماراته وحيّزاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، أي بالحرية الشاملة التي فرضتها بنية المجتمع الحديث والشروط التارخية لولادته، والتي تحسسها المثقف النهضوي حتى وإن لم يقرأ أطروحة هيغل عن مراحل الحرية الثلاث عبر التاريخ البشري: حرية الفرد الواحد في عهود الطغيان القديمة، حرية الأقلية في العصر اليوناني المرتكز على الرق وحرية المجموع في العصر الحديث، حيث من المعروف تاريخيا أن انتشار المثل الأعلى للحرية الشاملة كان مرتبطا ببداية عصر التصنيع ولم يكن من الممكن أن يبدأ إلا بعد أن مهدت له الطريق كشوف العلم الحديث منذ القرن السابع عشر، وربما قبل ذلك .
وهنا يظهر الارتباط واضحا بين النهضة العلمية الحديثة وبين توسع نطاق الحرية، فارتباط التقدم العلمي بحرية الفكر، وبالديموقراطية، فكرة أساسية في جميع كتابات كارل بوبر، نظرا لأن منطق التفكير العلمي يرفض التعلق بنتيجة علمية مهما بلغت نجاحاتها الاختبارية، فالعقل العلمي في جوهره مضاد للدوغمائية، التي تميز الميتافيزيقا الحتمية للاستبداد. "فما يميز العقل العلمي عن العقل ما قبل العلمي هو سمة التقدم المستمر، أي استعداده الدائم لكشف مواطن الضعف والخطأ في نظرياته وعدم تردده في انتقادها بلا هوادة والتخلي عنها كليا إذا لزم الأمر.




 الصالون الأدبي
الصالون الأدبي






 على المجهود الجامد بالرغم انى مفبش حد علق على هذا الموضوع الرائع حقاااا رائع وباريت نشوف جديد فى مجال البحث العلمى
على المجهود الجامد بالرغم انى مفبش حد علق على هذا الموضوع الرائع حقاااا رائع وباريت نشوف جديد فى مجال البحث العلمى