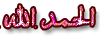 ، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛فهذه قراءة حول كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" وقد طُبع الكتاب في دار عالم الفوائد كاملاً لأول مرة عن سبع مخطوطات في مجلد واحد، وعن هذه الطبعة استفدت.
وهذا الكتاب يُعد من أهم ما أُلف في هذا الباب، بل هو معدود في مضمار الكتب الأساسية في هذا الفن -إن لم يكن قد أربى عليها-، وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم قديمًا وحديثـًا، حتى دفع ذلك المستشرق الفرنسي "هنري لاوست" -وكان متخصصًا في ابن تيمية، وله رسالة دكتوراه بعنوان: "آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية"- أن يقول:
"إن هذا الكتاب الجليل لهو أحد الآثار الإسلامية الكبرى في القانون الدولي، وأنا من جانبي لا أتردد مطلقًا في وضعه في مستوى الأحكام السلطانية للماوردي" انظر ط. عالم الفوائد لكتاب السياسة ص6.
فهذا الكتاب رتبه مؤلفه -رحمه الله- ترتيبًا بديعًا يدل على عمق الفكرة، وتمام التصور للموضوع الذي تكلم فيه، ويدل على قدرة المؤلف العجيبة على حسن الترتيب والتقسيم والبيان، فهو يصدق عليه قول كمال الدين بن الزملكاني وغيره: "وكانت له اليد الطـُّولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين... " انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" ص252، ط عالم الفوائد.
وسيزداد العجب والإعجاب إذا علمنا أنه ألـَّف هذا الكتاب في ليلة واحدة كما جاء في أحد مخطوطات الكتاب، وإنْ كان هذا من دأب المؤلف كما فعله في كتب أخرى: كالواسطية، والحموية، وغيرها من مؤلفاته -رحمه الله تعالى- فليس بمستغرب منه ذلك.
بدأ المصنف كتابه -وكان موفقـًا غاية التوفيق- بالأصل الذي بنى عليه هذا الكتاب، ثم بانتزاع الدلالة منه، فقال -رحمه الله-:
"وهذه رسالة مبينة على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله -تعالى-: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء:58).
فبيَّن أن الآية نزلت في ولاة الأمور، وأنها أوجبت عليهم أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، وهذان الأمران هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وهو مقصود هذا الكتاب، فبيَّن ووضَّح أن هذه رسالة تتضمن جوامع السياسة الإلهية والإيالة النبوية التي لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت عنه من غير وجه: (إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثـًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ) (رواه مسلم).
وعلى تفصيل مباحث الكتاب: ومضامينه بيَّن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن السياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان:
الركن الأول: أداء الأمانات.
الركن الثاني: الحكم بالعدل.
أما أداء الأمانات ففيه نوعان:
أحدهما: الولايات، وهو كان سبب نزول الآية.
فيجب على وليِّ الأمر أن يولِّي على كل عملٍ من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل.
وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نُوَّابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نُوَّاب السلطان والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومُقدِّمي العساكر الكبار والصغار، وولاة الأموال؛ من الوزراء والكتاب والسُّعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين.
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة، والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمراء الحاج، وخُزَّان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين -الذين هم البوابون على الحصون والمدائن- ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعُرَفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى وغيرهم.
فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع، فإن عَدَل عن الأحقِّ الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما أو لِرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لِضِغَنٍ في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نُـهي عنه في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (الأنفال:27-28).
فإن الرجل لحبه لولده أو لغيره، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثر زيادةً ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله والرسول وأمانته.
ثم بين -رحمه الله-: أنه قد دلت سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن الولاية أمانة يجب أداؤها. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلقَ عبادُ الله، والولاة نُوَّاب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة وذكر -رحمه الله- أدلة كل ذلك.
ثم قرر -رحمه الله-: أنه إذا عُرِفَ هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخْذِه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذه المواضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله.
وإن اختلَّت بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، لكن إن كان منه عجزٌ فلا حاجة إليه، أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يُعرف الأصلح في كل منصب.
وبيَّن -رحمه الله- أن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة:
1- فالقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها -فإن الحرب خدعة- وإلى القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن وضرب، وركوبٍ وكر ًّوفرًّ ونحو ذلك.
والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام.
ثم بيَّن -رحمه الله-: أن الولايات تجمع قوة المرء في نفسه، وقوته على غيره؛ فقوته على نفسه بالحلم والصبر، وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة في نفسه، والخبرة وسائر أسباب القوى من الرجال والأموال، كما دل عليه قوله -تعالى-: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) (الأنفال:60).
فبالقوة الأولى: يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله عنه، ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله، وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والهوى.
وبالقوة الثانية: يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله، الذين جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله، وبهم يقوم الدين.
2- والأمانة ترجع إلى خشية الله -تعالى- وترك خشية الناس، وألا يُشترى بآياته ثمنًا قليلاً، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كلِّ حَكَمٍ على الناس، في قوله -تعالى-: (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44).
ثم بيَّن -رحمه الله تعالى-: أن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "اللهم أشكوا إليك جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة".
فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا عُيِِّنَ رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررًا فيها، فيُقَدَّم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع -وإن كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينًا.
وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قـُدِّم الأمين، مثل: حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة، فيولي عليها قوي يستخرجها بقوته، وكاتبٌ أمينٌ يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جُمِع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولَّى إذا لم تقع الكفاية بواحدٍ تام.
ثم وضَّح -رحمه الله-: أن المهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عُرِفَت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدَّموا في ولايتهم من يُعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته.
ثم بيَّن -رحمه الله- المقصود الواجب بالولايات: وهو إصلاحُ دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نَعِمُوا به في الدنيا، وإصلاحُ ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. فمن لم يَعْتَدِ أصلحَ له دينَه ودنياه.
ثم بيَّن -رحمه الله- ما آل إليه الحال: أنه لما تغيرت الرعية من وجه، والرعاة من وجه، تناقضت الأمور. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله -تعالى- فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.
ثم بيَّن -رحمه الله- النوع الثاني من الأمانات: وهو الأموال كما قال الله -سبحانه وتعالى- في الديون: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) (البقرة:283).
ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والـمُوَكِّل، والمضارب، ومال المولَّى من اليتيم وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصَدُقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك.
وبيَّن أن: هذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كل ذي السلطان ونُوَّابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جُباة الأموال أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق.
وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق.
وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالكُ ملكه، فإنما هم أُمَناء ونُوَّاب ووُكَلاء، ليسوا مُلاَّكًا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ) (رواه البخاري).
فهذا رسول ربِّ العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله، وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله -سبحانه وتعالى-.
ثم وضَّح شيخ الإسلام: أن الأموال التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.
فأما الغنيمة: فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، والواجب في الـمَغْنَم تخميسه، وصرف الخُمُس إلى من ذكره الله -تعالى-، وقِسْمةُ الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "الغنيمة لمن شَهِد الوقعة"؛ وهم الذين شهدوها للقتال، قاتَلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قَسْمُها بينهم بالعدل، فلا يُحَابَي أحدٌ لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه يقسمونها.
وأما الصدقات: فهي لمن سمى الله -سبحانه وتعالى- في كتابه.
وأما الفيء: فأصله ما ذكره الله -سبحانه وتعالى- في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) (الحشر:6).
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَض من الأموال، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، والفيء، وغير ذلك.
ثم بيَّن ما حدث من تغيير في ذلك الأمر بعد ذلك: فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة أنواع:
- نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر سابقـًا.
- وقسم يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حدٍّ ارتكبه، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقـًا.
- وقسم فيه اجتهاد وتنازع، كمَالِ من له ذو رحم ليس بذي فرضٍ ولا عَصَبَة، ونحو ذلك.
وبيَّن -رحمه الله- أن كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يَتْرك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل.
ثم بيَّن الأصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري ـرضي الله عنهـ: "هدايا العمال غلول".
ثم بيَّن أنه: لما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كلِّ إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له.
فليجتهد المسلم في التقرُّب إليها بجهده، ويستغفر الله -تعالى- بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمالَ ما بَعَث الله به محمدًا -صلى الله عليه وسلم- من الدين.
فهذا في قوله -تبارك وتعالى-: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء:58)، وهو الركن الأول من أركان السياسة العادلة "أداء الأمانات".
وللحديث بقية -إن شاء الله-...




 المنتديات العامة
المنتديات العامة 









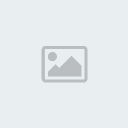



 ابو مصعب
ابو مصعب
