أيها الشباب: اتقوا الله، ويا أيها الولاة: خافوا الله
المصدر موقع الرحمة المهداة www.mohdat.com
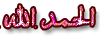 رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فالمسلم مطالب أن يلزم أمر الله - تعالى -، وألا تغلبه العاطفة، أو يستجرَّه الشيطان المعصية، والاعتراض على القدر، أو يبلغ به الجزع مبلغاً يدفعه لارتكاب خطيئة توبقه، حتى وإن ظن أنها ليست كذلك، أو حاول بعض قاصري النظر ادِّعاء أنها إحدى وسائل التأثير والتعبير.
إنني وأنا أتابع ماتطالعنا به الصحف ووسائل الإعلام هنا وهناك، من محاولات متكررة، وأساليب متنوعة، لمعاجلة النفس بإزهاقها، والتعبير عن حالة القهر والمرارة، بالخلاص من هذه الحياة، التي صار يرى الموت عندها رحمة ونجاة، وهي أساليب اختلف، فمن شنق النفس، إلى محاولة التردي من شاهق، إلى إحراق الأجساد بالنار عياذاً بالله، وهو الأمر الذي تتابع تتابعاً مقلقاً، يوجب على أهل العلم والدعوة المسارعة في بيان خطره، والتعاون في إيجاد الحلول والسبل لمعالجة أسبابه، وإلا فإن فاعله آثم، ومن قدر على منعه بأي وسيلة ثم لم يفعل فإنه آثم كذلك.
أنا أتفهَّم أن يخرج شاب لا يدين بدين، ولم ينعم يوماً في حياته بمناجاة الله - تعالى -، أولم يعرف من هذه الحياة إلا ما تعرفه البهائم: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) فيزهق نفسه ويعاجلها، عند غياب تلك اللذة وذلك المتاع، أما أن يفعل ذلك مسلم ذاق حلاوة المناجاة، وقرأ ما أعدَّه الله للصابرين، وآمن أن لله حكمة في الابتلاء، وأن الدنيا دار امتحان، وأنها سجن المؤمن، وجنة الكافر، وأن الفقر والجوع والظلم والخوف مما يمتحن الله به عباده، ليرى صدق صبرهم، ومدى توكلهم، أو يعاقبهم به لذنب اقترفوه، أو لغير ذلك من الحكم العظيمة التي يريدها الله، فإن هذا من المسلم - مما يدمي القلب، ويفتت الكبد، وذلك لأن فاعله مهدد بعذاب من الله - تعالى - أشد، وعقوبة أنكى، فهو إنما فرَّ من جحيم الدنيا إلى جحيم الآخرة، وهو بفعله هذا يعترض على حكمة الله - تعالى - وحكمه، الذي قسم الأرزاق، وقدَّر الأقوات.
لعل قائلاً يقول: إنني لا أعترض على فضل الله الذي يهبه لمن يشاء، ولكني أعترض على تلك الممارسات التي نراها ونسمعها، مما يصبح معها الحليم حيراناً، والغافل مشدوهاً، من تبذير لثروات الأمة، ونهب لمقدَّراتها، لا يستحيي أصحابها من مجاهرتهم بها، في حين يمنون على البسطاء بفتاتٍ هو بعض حقهم المشروع، وأعترض على تلك التخبطات، التي قلبت الموازين، وفاقمت المشكلة، هذا محل اعتراضي، أما من سعى واجتهد، فبارك الله له فيما آتاه، ووسَّع عليه في دنياه، فإن هذا ممن فضَّله عليَّ، ولا اعتراض على فضل الله.
والحقيقة أن الوقوف عند هذه الاعتراضات مهم جداً، ولعلي قبل أن أقف عندها أستحضر بعض ما ورد في شريعة الله، من نصوص توجب على المسلم مراعاتها، والوقوف عندها، مما ورد فيها النهي عن قتل النفس ومعاجلتها، قبل إيرادها يحسن أن أشير إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم من قتل نفسه في صفوف العدو، أو فجَّر نفسه في مصالحهم للإضرار بهم، وهل يُعدُّ منتحراً أم لا، فما ظنُّك بمن هو دون ذلك بكثير، ممن يقتل نفسه للتخلص مما يجده من عناء الدنيا ومنغصاتها، مما ضعفت نفسه أو ضاقت عن تحمُّله.
ومما جاء في الشريعة في النهي عن استعجال النفس قوله جل جلاله: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)) أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيهما عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة))، وعند مسلم - رحمه الله -، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ((أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه)) والمشاقص السهام العراض، وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحزَّ بها يده فما رقأَ الدم حتى مات. قال الله - تعالى -: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)).
ولو أن المسلم إذا ضاقت نفسه، وعجز عن دفع ما يجده، تذكَّر ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)).
وهذه نصوص صريحة لا تقبل التحريف ولا التأويل، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها لبعض النتائج المُتوقَّعة، ومن ظنَّ أن ما يفعله بعض الناس اليوم، من قتْل أنفسهم بأي صُور القتل، من أنواع التعبير المشروع، أو مما تحتاجه الأمة، أو غير ذلك من المبررات، فو كاذب على شريعة الله، غاشٌّ لأمة الإسلام، والواجب على هؤلاء ألاَّ يدفعوا المقهورين ليكونوا حطباً للنار في الدنيا والآخرة، بل عليهم إن كانوا صادقين أن يجتهدوا في السعي للمقهورين بما يقوي إيمانهم، ويزيد ثباتهم على الحق من جهة، وبما يفتح لهم أبواب السعي والتَّكسب المشروع من جهات أخرى، وتذكيرهم دائماً بأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، وأن الإنسان مهما أصابه فيها، فعليه أن يتذكر هدي أفضل الخلق - صلى الله عليه وسلم -، الذي كان منه ما حكت عائشة - رضي الله عنها - لابن أختها عروة ابن الزبير - رضي الله عنه - بقولها: "ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانهم فيسقينا"، وقالت - رضي الله عنها - في موضع آخر: "ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز الشعير حتى قبض"، وحكى عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيت الليالي طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير"، وأما أبو هريرة - رضي الله عنه - فقد قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ طَعَامُنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّمْرَ وَالْمَاءَ، وَاللَّهِ، مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَاءَكُمْ هَذِهِ، وَلَا نَدْرِي مَا هِيَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّمَارَ، يَعْنِي: بُرُدَ الْأَعْرَابِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ.
والآن أعود إلى تلك الاعتراضات، وهي لا تبيح مهما بلغت في قوتها، أن يعاجل الإنسان نفسه، بل على المسلم أن يصبر، فإن عجِز فليتصبَّر: (ومن يتصبَّر يُصبِّره الله)، وأن يعلم أن للكون ربّاً يديره، وهو- سبحانه - يرى ويعلم ما يقع، ولا يخفى عليه شيء: (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء)، فإن كان ما وقع للمسلم وقع له وهو صحيح الحال في دينه، قائم بأمر ربه كما ينبغي، فإن ذلك ابتلاء يبتليه الله به، وعاقبته له إن قابله بالصبر والصدق: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)، وأما إن قابله بغير ذلك: (فمن سخط فله السخط)، أما إن وقع له وهو مقصِّر بحق ربه، مُعرض عن أمره، فإن ذلك عقاب من الله، وهنا فعلى المسلم أن يبادر بالرجوع إلى الله، والانكسار بين يديه، لأنه: ((ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة))، وقد تكون العقوبة من الله للعبد مباشرة، إما بآفة في ماله، أو نفسه، أو أهله، أو غير ذلك من العقوبات، أو تكون بظلم يقع عليه من سلطان، أو مدير، أو مسؤول، فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا معشر المهاجرين خمس خصال و أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خَفَرَ قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم))، وقال الحسن - رحمه الله -: "اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله - تعالى -، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: "اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنباً أحدث الله في سلطانكم عقوبة "، ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج: "إنك تفعل بأمة رسول الله كيت وكيت!"، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شراع نبيهم - عليه السلام - ما تركوا".
والمقصود أن ما يعترض العبد في حياته من الضيق والشدة في معيشته ورزقه، لا يخرج من دائرة الابتلاء والعقوبة، وأن ما يكون منه عقوبة، يوجب المبادرة بالتوبة، سواء ما كان عقوبة مباشرة، أو ما كان بجور السلاطين والحكام وذوي الرياسات، وهذا لا يعني أن العبد يستسلم ويسكت، بل كما وجب تذكير الناس بالتوبة لله - تعالى -، فإنه يجب تذكير السلاطين والحكام وذوي الرياسات بالعدل، ورفع الظلم، وإزالة مظاهر القهر للناس.
إنه كما يُنصح الناس بلزوم السمع والطاعة للحاكم بالمعروف، ومعاملة ما يقع منه على نحو ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى وفق ما وجَّه به أئمة الإسلام، فإن السلاطين وغيرهم يُنصحون ويُوجَّهون بلزوم شرع الله - تعالى -، ويُحتسب عليهم، وهذا من تكامل الشريعة وعظمتها، فالذي جاء بـ: ((اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية))، هو الذي جاء بـ ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))، ويجمع هذا وذاك ما رواه مسلم - رحمه الله - عن أبي رُقَيَّةَ تَميمِ بنِ أوْسٍ الدَّاريِّ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ))، قُلْنَا: لِمَنْ؟، قالَ: ((للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).
وعلى هذا الأساس، ومن هذا المنطلق، فالنصيحة لحكام المسلمين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً أن يتقي الله فيهم، وأن يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))، ويقول: ((ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة))، ويقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به))، وأن يسوسوهم بشريعة الله، ويعدلوا بينهم في الأحكام، ويحسنوا إليهم في الأعطيات، وألا يمنعوهم حقوقهم، وألا يغشوهم في شيء من أمرهم.
وإنه لعار وخزي، وجريمة أيُّ جريمة، أن يُحرق شاب نفسه بالنار، أو يعلق نفسه في شاخص، أو يتدهده من جبل، أو يلقي نفسه من بناية، لقلة ذات يده، أو لعوزه وشدته، وبلاد المسلمين تتربع على أغلى وأكثر ثروات العالم.
إن على ولاة أمر المسلمين أن ينظروا في أحوال مجتمعاتهم، ويتفقدوا مواطن الخلل، وينتدبوا لذلك النصحاء والصلحاء، وأن يحذروا الغششة والمنتفعين، وأن يكفوا عن مظاهر الظلم، وقهر المجتمعات بالتصرفات غير السوية، فالشاب الذي لا يجد ما يدفع به ضراوة الجوع، يزيد في قهره وغضبه ما يراه من نفقات لا حصر لها على أضرابه من أبناء العلية والساسة.
والذي لا يجد سكنا يؤويه، أو يصبِّحه صاحب السكن الذي هو فيه بمطالبته بالأجرة ويُمسِّيه، يقهره ويشعل النار في قلبه حين يسمع أنا فلانا اشترى فندقاً، أو يختاً، أو سيارة فارهة، أو أحيا ليلة، أو استأجر منتجعاً، أو أقام مأدبة، وأن ذلك بلغ ملايين الدولارات، أو جاوزها إلى المليارات، وهو يعلم أن فاعل ذلك لم يعمل في تجارة، أو يحصل على تلك الأموال من مرتبات وظيفته المدَّخرة، وليست مما ورثها عن أبيه، أو أحد قراباته المتوفين، ولم يعثر على كنز مدفون، وإنما أخذها، أو إن شئت فقل سلبها من أموال الناس وحقوقهم.
كلنا سمعنا عن حالات البذخ التي ينعم بها فئات من الناس دون غيرهم، وسمعنا عن صور الإنفاق غير المشروع، وكل مجتمعات المسلمين تتحدث عن مشاهد مؤلمة، فهل نظن أن هذه الصور والمشاهد لن تترك أثراً في قلوب المعدمين والضعفاء؟، وقل مثل ذلك في حالات التبذير غير المبرر، وذلك كالإنفاق على لاعبي الكرة بما لا يخطر على بال، حتى إن بعضهم بلغ عقد استضافته عشرات الملايين، في وقت يتقاتل فيه آلاف الشباب على حفنة من الوظائف ذات المرتَّبات المتدنية، وبُحَّت أصوات كثير منهم وهم ينادون بتصحيح أوضاعهم، أو ترسيمهم، مع أننا لا نرى في الكرة التي تنفق لأجلها الملايين إلا مزيداً من الإخفاقات والفشل.
إن ولاة المسلمين مؤتمنون على الثروات، وهم عليها كالقاسم، ولذا فالواجب عليهم أن يصرفوها بحق وعدل، وأن يتحروا فيها ما يُصلح الناس، ويَصلُح للناس، وأن يعلموا أن الله سائلهم عنها يوم يقفون بين يديه، ولله در عمر الفاروق - رضي الله عنه - حين قال: "لو أن بغلة في العراق عثرت لعلمت أن الله سيسألني عنها"، فليعدوا للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، وإن من الجواب وصوابه أن تُساس المجتمعات بكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يكون الناس في الحقوق سواسية، وأن يكون شعار الحاكم والمحكوم " من أين لك هذا "، فإن كان من حقوق الناس أعيد إليهم، وإن كان مما أقدره الله على كسبه بالصفة الشرعية، فبارك الله له فيه، ورزقه وأعانه.
كما إن من الجواب والصواب، أن تتحمل القيادات مسؤوليتها بصدق، وألا تقهر الناس لتخرجهم عن طورهم، وتمارس في الوقت ذاته سياسة الاستفزاز البغيض، وتجعل شعارها "جوِّع ****ك يتبعك "، فإن الناس ليسوا كذلك، والإنسان المسلم وُلد حرَّاً، وهو يعشق الحرية فـ " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "، وإذا كانت الدول ترغب من شعوبها الوقوف معها حال الأزمات والشدائد، فكذلك الشعوب تريد من قياداتها الوقوف معها عند الرخاء واليسر.
إن الجموع المحتاجة المحتجة، التي ترى أن الوظائف لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد أن يموت دونها أعداد وأعداد، ثم يتنامى إلى سمعها أن امرأة أخذت معها طناً ونصف الطن من الذهب دفعة واحدة، فإنه لا يمكن أن تمنح الولاء والحب، ولا أن تلتمس العذر للحاكم مهما حاول الاعتذار.
ما الذي يضير هذه الدول أن تفتح المصانع الضخمة، بدلاً من تشييد الملاعب، وما الذي يمنع من إنشاء المراكز التدريبية المفيدة، بدلاً من إغراق المجتمعات بالمسارح والملاهي.
إننا حين نتحدث عن البطالة وأخطارها، وبلداننا تتربع على أعظم الثروات المعدنية والنفطية، وفي مقابل ذلك نستورد من الخارج كل شيء، وكأن عقول من نستورد منهم أنضج من عقولنا، ويجلس أبناء المجتمع ينتظرون دورهم في الوظائف الإدارية، أو بعض الوظائف الخدمية والعسكرية، حتى إذا تعذرتهم تلك الدوائر، وجدوا أنفسهم أمام فراغ قاتل، وفقر قاهر، فإن هذا يوجب علينا مراجعة السياسات والخطط، والالتفات إلى ما أودعه الله عندنا، والاستفادة من قدرات رجالنا وفتياتنا، وذلك من خلال الاهتمام بالمجال الفني والمهني، وإنشاء مراكز ضخمة للتدريب، ومصانع تستقبل هؤلاء المتدربين، وإتاحة الفرصة لهم للدخول في سوق العمل بقوة وثقة، ومنحهم الأولوية، وتذليل كل العقبات التي تحول بينهم وبين الاستمرار والمنافسة، ولعلي هنا أستشهد بنموذج واحد فقط يوجد لدينا في السعودية، وهو مراكز ومعاهد التدريب الفني والتعليم المهني، كم عمرها الفعلي؟، وكم الأعداد التي تخرَّجت منها؟، وما هو دورها في الواقع؟، وما أسباب تخلف المتخرجين عن المنافسة أو تطوير الذات؟، وأين ذهبت تلك الأعداد التي تخرجت؟، مع أنها كانت تتعلم مهناً لا غنى للناس عنها، كالحدادة، والنجارة، والكهرباء، والميكانيكا، والسمكرة، وغير ذلك مما لا نراه اليوم إلا بيد العمالة الوافدة، فهل كان التعليم لا يرقى للمنافسة؟، أم حال بينهم وبين المنافسة أسباب فنية؟، أم ماذا يا ترى؟.
على الدول أن تبدأ فعلياً بالاستفادة من الطاقات المهدرة، والمقدَّرات المبعثرة، وأن تفكِّر مليِّاً، وتبادر سريعاً، بإعادة ترتيب الصفوف، ومنع مظاهر الفساد والتفرقة، وأن تستشعر أن حرمان تلك المجتمعات من شيء تشعر أنها أولى به، سيولد عندها الاحتقان، وسيدفعها للانتقام، خاصة إذا بلغ الأمر حداً مزعجاً، أو وجد من يستغل ذلك الظرف، ثم ينفخ فيه النار.
بل يجب على ولاة الأمر أن يتحركوا لإصلاح مواطن الخلل كلها، وألا يقتصر العلاج على أمر المعيشة، وقضية البطالة، وغلاء الأسعار، بل يجب التحرك لإصلاح كل خلل يمس الضرورات الخمس، وأن يكون ذلك هو الشغل الشاغل، أما أن ينتظر الولاة حتى يغضب الناس، أو يصلوا إلى حدِّ الضجر، وبعدها يُفكرون بالتحرك واتخاذ بعض القرارات التخديرية، فهذا هو الغش بعينه.
وليس لأحد عذر في التبرير للبطالة بأنها موجودة في الدول المتقدمة، وأنها مشكلة عالمية، وذلك لأننا لم نضع حلولاً عملية للبطالة، بل اكتفينا بهذا العذر البارد، وإلا فلو كنا نمتلك المصانع، وننتج السلع، وقد اكتفينا ذاتياً، وأصبحنا نغزوا أسواق العالم بمنتجاتنا، فهنا يمكن أن نعتذر بالعالمية ومشاكلها، أما أن نستورد من الخارج معظم ما نحتاجه، مع أن بإمكاننا أن ننتجه هنا، فنحن والحالة هذه لا حجة لنا بما يقع عند غيرنا، ولعلي هنا أن أشير إلى قصة وقعت لي، حيث كنت مرة في سوريا، وعرض علي أحدهم زيارة مصنع للأحذية هناك، وذكر أنه لأحد أقربائه، وعندما ذهبنا للمصنع، وجدته لا يتجاوز في مساحته أربعة أمتار في ستة، وقد كنت أتصور أنه أكبر من هذا بمئات المرات، وقد كنت أضحك بيني وبين نفسي، وكنت أقول وأردد: مصنع! مصنع!، ومما زاد دهشتي ما ذكره صاحب المصنع من أنه يُصدِّر للسعودية، وأنه يشتري منه عدد من تجار الأحذية هنا، عندها وقفت وقفة صمت وحسرة، كنت أفكِّر معها وأقول: هذا المكان المتواضع، وهذا الجهد مع هذه العزيمة الصادقة، لو قام أمثالها في بلادنا، فكم ستستفيد منها من أسرة؟، وكم ستتاح فيها من وظيفة؟، وحتى لو أخفق بعضهم، أو تعثَّر في مسيرته، فما المانع أن تتاح أمامه الفرص، ويشجع ليقف على قدميه مرة أخرى.
إن شبابنا لا يقلون في مواهبهم، ولا في عقلياتهم، ولا في قدراتهم، عن غيرهم من سائر الشباب، لكنهم يجب أن يُصرفوا لما ينفعهم، ويستفاد من تلك العقول والمواهب والقدرات، أما أن تُترك لسهام التغريب والتخريب والتشويه والتشويش، من خلال القنوات، أو ما يروَّج من المخدرات، أو ما يُهيَّأ لهم من المغريات والملهيات، فهذا من الغش والخيانة، و ((من غشنا فليس منا)).
متى سنجد مدنا صناعية تستقطب آلاف الشباب، وتمنحهم فرصة العيش بكرامة، وتُكسبهم الخبرة والتجربة، وتجعلهم لبنات صالحة في المجتمع، وأعني بها المدن الصناعية الفعلية، وليست تلك المدن الأسطورية، التي رُصدت لها المليارات، وبقيت شاهدة باسمها، غائبة أو مُغيَّبة في حقيقتها وواقعها.
وإلى هنا أقف، وللحديث بقية، أستكملها قريبا بحول الله.
اللهم أعذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واعصمنا بالكتاب والسنة، واجعلنا من أنصار دينك، وحملة لواء شريعتك، والذابين عن حياضها.
اللهم عليك بالفجرة المنافقين، والخونة الليبراليين، والرجس العلمانيين، والرافضة المفسدين.
اللهم اهتك سترهم، وزدهم صغارا وذلا، وأرغم آنافهم، وعجل إتلافهم، واضرب بعضهم ببعض، وسلط عليهم من حيث لا يحتسبون.
اللهم اهدِ ضال المسلمين، وعافِ مبتلاهم، وفكَّ أسراهم، وارحم موتاهم، واشفِ مريضهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكسُ عاريهم، وانصر مجاهدهم، وردَّ غائبهم، وحقق أمانيهم.
اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك مؤيدا وظهيرا، ومعينا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وأمكنهم من رقاب عدوهم، وافتح لهم فتحا على فتح، واجعل عدوهم في أعينهم أحقر من الذر، وأخس من البعر، وأوثقه بحبالهم، وأرغم أنفه لهم، واجعله يرهبهم كما ترهب البهائم المفترس من السباع.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا.
اللهم أصلح الراعي والرعية.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، واحفظ عليها دينها، وحماة دينها، وورثة نبيها، واجعل قادتها قدوة للخير، مفاتيح للفضيلة، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إن نسوا، وتعينهم إن تذكروا، واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، يا سميع الدعاء.
هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر موقع الرحمة المهداة www.mohdat.com
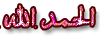 رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:
فالمسلم مطالب أن يلزم أمر الله - تعالى -، وألا تغلبه العاطفة، أو يستجرَّه الشيطان المعصية، والاعتراض على القدر، أو يبلغ به الجزع مبلغاً يدفعه لارتكاب خطيئة توبقه، حتى وإن ظن أنها ليست كذلك، أو حاول بعض قاصري النظر ادِّعاء أنها إحدى وسائل التأثير والتعبير.
إنني وأنا أتابع ماتطالعنا به الصحف ووسائل الإعلام هنا وهناك، من محاولات متكررة، وأساليب متنوعة، لمعاجلة النفس بإزهاقها، والتعبير عن حالة القهر والمرارة، بالخلاص من هذه الحياة، التي صار يرى الموت عندها رحمة ونجاة، وهي أساليب اختلف، فمن شنق النفس، إلى محاولة التردي من شاهق، إلى إحراق الأجساد بالنار عياذاً بالله، وهو الأمر الذي تتابع تتابعاً مقلقاً، يوجب على أهل العلم والدعوة المسارعة في بيان خطره، والتعاون في إيجاد الحلول والسبل لمعالجة أسبابه، وإلا فإن فاعله آثم، ومن قدر على منعه بأي وسيلة ثم لم يفعل فإنه آثم كذلك.
أنا أتفهَّم أن يخرج شاب لا يدين بدين، ولم ينعم يوماً في حياته بمناجاة الله - تعالى -، أولم يعرف من هذه الحياة إلا ما تعرفه البهائم: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) فيزهق نفسه ويعاجلها، عند غياب تلك اللذة وذلك المتاع، أما أن يفعل ذلك مسلم ذاق حلاوة المناجاة، وقرأ ما أعدَّه الله للصابرين، وآمن أن لله حكمة في الابتلاء، وأن الدنيا دار امتحان، وأنها سجن المؤمن، وجنة الكافر، وأن الفقر والجوع والظلم والخوف مما يمتحن الله به عباده، ليرى صدق صبرهم، ومدى توكلهم، أو يعاقبهم به لذنب اقترفوه، أو لغير ذلك من الحكم العظيمة التي يريدها الله، فإن هذا من المسلم - مما يدمي القلب، ويفتت الكبد، وذلك لأن فاعله مهدد بعذاب من الله - تعالى - أشد، وعقوبة أنكى، فهو إنما فرَّ من جحيم الدنيا إلى جحيم الآخرة، وهو بفعله هذا يعترض على حكمة الله - تعالى - وحكمه، الذي قسم الأرزاق، وقدَّر الأقوات.
لعل قائلاً يقول: إنني لا أعترض على فضل الله الذي يهبه لمن يشاء، ولكني أعترض على تلك الممارسات التي نراها ونسمعها، مما يصبح معها الحليم حيراناً، والغافل مشدوهاً، من تبذير لثروات الأمة، ونهب لمقدَّراتها، لا يستحيي أصحابها من مجاهرتهم بها، في حين يمنون على البسطاء بفتاتٍ هو بعض حقهم المشروع، وأعترض على تلك التخبطات، التي قلبت الموازين، وفاقمت المشكلة، هذا محل اعتراضي، أما من سعى واجتهد، فبارك الله له فيما آتاه، ووسَّع عليه في دنياه، فإن هذا ممن فضَّله عليَّ، ولا اعتراض على فضل الله.
والحقيقة أن الوقوف عند هذه الاعتراضات مهم جداً، ولعلي قبل أن أقف عندها أستحضر بعض ما ورد في شريعة الله، من نصوص توجب على المسلم مراعاتها، والوقوف عندها، مما ورد فيها النهي عن قتل النفس ومعاجلتها، قبل إيرادها يحسن أن أشير إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم من قتل نفسه في صفوف العدو، أو فجَّر نفسه في مصالحهم للإضرار بهم، وهل يُعدُّ منتحراً أم لا، فما ظنُّك بمن هو دون ذلك بكثير، ممن يقتل نفسه للتخلص مما يجده من عناء الدنيا ومنغصاتها، مما ضعفت نفسه أو ضاقت عن تحمُّله.
ومما جاء في الشريعة في النهي عن استعجال النفس قوله جل جلاله: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)) أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيهما عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة))، وعند مسلم - رحمه الله -، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ((أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه)) والمشاقص السهام العراض، وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحزَّ بها يده فما رقأَ الدم حتى مات. قال الله - تعالى -: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)).
ولو أن المسلم إذا ضاقت نفسه، وعجز عن دفع ما يجده، تذكَّر ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)).
وهذه نصوص صريحة لا تقبل التحريف ولا التأويل، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها لبعض النتائج المُتوقَّعة، ومن ظنَّ أن ما يفعله بعض الناس اليوم، من قتْل أنفسهم بأي صُور القتل، من أنواع التعبير المشروع، أو مما تحتاجه الأمة، أو غير ذلك من المبررات، فو كاذب على شريعة الله، غاشٌّ لأمة الإسلام، والواجب على هؤلاء ألاَّ يدفعوا المقهورين ليكونوا حطباً للنار في الدنيا والآخرة، بل عليهم إن كانوا صادقين أن يجتهدوا في السعي للمقهورين بما يقوي إيمانهم، ويزيد ثباتهم على الحق من جهة، وبما يفتح لهم أبواب السعي والتَّكسب المشروع من جهات أخرى، وتذكيرهم دائماً بأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، وأن الإنسان مهما أصابه فيها، فعليه أن يتذكر هدي أفضل الخلق - صلى الله عليه وسلم -، الذي كان منه ما حكت عائشة - رضي الله عنها - لابن أختها عروة ابن الزبير - رضي الله عنه - بقولها: "ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانهم فيسقينا"، وقالت - رضي الله عنها - في موضع آخر: "ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز الشعير حتى قبض"، وحكى عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيت الليالي طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير"، وأما أبو هريرة - رضي الله عنه - فقد قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ طَعَامُنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّمْرَ وَالْمَاءَ، وَاللَّهِ، مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَاءَكُمْ هَذِهِ، وَلَا نَدْرِي مَا هِيَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّمَارَ، يَعْنِي: بُرُدَ الْأَعْرَابِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ.
والآن أعود إلى تلك الاعتراضات، وهي لا تبيح مهما بلغت في قوتها، أن يعاجل الإنسان نفسه، بل على المسلم أن يصبر، فإن عجِز فليتصبَّر: (ومن يتصبَّر يُصبِّره الله)، وأن يعلم أن للكون ربّاً يديره، وهو- سبحانه - يرى ويعلم ما يقع، ولا يخفى عليه شيء: (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء)، فإن كان ما وقع للمسلم وقع له وهو صحيح الحال في دينه، قائم بأمر ربه كما ينبغي، فإن ذلك ابتلاء يبتليه الله به، وعاقبته له إن قابله بالصبر والصدق: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)، وأما إن قابله بغير ذلك: (فمن سخط فله السخط)، أما إن وقع له وهو مقصِّر بحق ربه، مُعرض عن أمره، فإن ذلك عقاب من الله، وهنا فعلى المسلم أن يبادر بالرجوع إلى الله، والانكسار بين يديه، لأنه: ((ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة))، وقد تكون العقوبة من الله للعبد مباشرة، إما بآفة في ماله، أو نفسه، أو أهله، أو غير ذلك من العقوبات، أو تكون بظلم يقع عليه من سلطان، أو مدير، أو مسؤول، فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا معشر المهاجرين خمس خصال و أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خَفَرَ قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم))، وقال الحسن - رحمه الله -: "اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله - تعالى -، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: "اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنباً أحدث الله في سلطانكم عقوبة "، ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج: "إنك تفعل بأمة رسول الله كيت وكيت!"، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شراع نبيهم - عليه السلام - ما تركوا".
والمقصود أن ما يعترض العبد في حياته من الضيق والشدة في معيشته ورزقه، لا يخرج من دائرة الابتلاء والعقوبة، وأن ما يكون منه عقوبة، يوجب المبادرة بالتوبة، سواء ما كان عقوبة مباشرة، أو ما كان بجور السلاطين والحكام وذوي الرياسات، وهذا لا يعني أن العبد يستسلم ويسكت، بل كما وجب تذكير الناس بالتوبة لله - تعالى -، فإنه يجب تذكير السلاطين والحكام وذوي الرياسات بالعدل، ورفع الظلم، وإزالة مظاهر القهر للناس.
إنه كما يُنصح الناس بلزوم السمع والطاعة للحاكم بالمعروف، ومعاملة ما يقع منه على نحو ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى وفق ما وجَّه به أئمة الإسلام، فإن السلاطين وغيرهم يُنصحون ويُوجَّهون بلزوم شرع الله - تعالى -، ويُحتسب عليهم، وهذا من تكامل الشريعة وعظمتها، فالذي جاء بـ: ((اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية))، هو الذي جاء بـ ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))، ويجمع هذا وذاك ما رواه مسلم - رحمه الله - عن أبي رُقَيَّةَ تَميمِ بنِ أوْسٍ الدَّاريِّ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ))، قُلْنَا: لِمَنْ؟، قالَ: ((للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).
وعلى هذا الأساس، ومن هذا المنطلق، فالنصيحة لحكام المسلمين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً أن يتقي الله فيهم، وأن يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))، ويقول: ((ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة))، ويقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به))، وأن يسوسوهم بشريعة الله، ويعدلوا بينهم في الأحكام، ويحسنوا إليهم في الأعطيات، وألا يمنعوهم حقوقهم، وألا يغشوهم في شيء من أمرهم.
وإنه لعار وخزي، وجريمة أيُّ جريمة، أن يُحرق شاب نفسه بالنار، أو يعلق نفسه في شاخص، أو يتدهده من جبل، أو يلقي نفسه من بناية، لقلة ذات يده، أو لعوزه وشدته، وبلاد المسلمين تتربع على أغلى وأكثر ثروات العالم.
إن على ولاة أمر المسلمين أن ينظروا في أحوال مجتمعاتهم، ويتفقدوا مواطن الخلل، وينتدبوا لذلك النصحاء والصلحاء، وأن يحذروا الغششة والمنتفعين، وأن يكفوا عن مظاهر الظلم، وقهر المجتمعات بالتصرفات غير السوية، فالشاب الذي لا يجد ما يدفع به ضراوة الجوع، يزيد في قهره وغضبه ما يراه من نفقات لا حصر لها على أضرابه من أبناء العلية والساسة.
والذي لا يجد سكنا يؤويه، أو يصبِّحه صاحب السكن الذي هو فيه بمطالبته بالأجرة ويُمسِّيه، يقهره ويشعل النار في قلبه حين يسمع أنا فلانا اشترى فندقاً، أو يختاً، أو سيارة فارهة، أو أحيا ليلة، أو استأجر منتجعاً، أو أقام مأدبة، وأن ذلك بلغ ملايين الدولارات، أو جاوزها إلى المليارات، وهو يعلم أن فاعل ذلك لم يعمل في تجارة، أو يحصل على تلك الأموال من مرتبات وظيفته المدَّخرة، وليست مما ورثها عن أبيه، أو أحد قراباته المتوفين، ولم يعثر على كنز مدفون، وإنما أخذها، أو إن شئت فقل سلبها من أموال الناس وحقوقهم.
كلنا سمعنا عن حالات البذخ التي ينعم بها فئات من الناس دون غيرهم، وسمعنا عن صور الإنفاق غير المشروع، وكل مجتمعات المسلمين تتحدث عن مشاهد مؤلمة، فهل نظن أن هذه الصور والمشاهد لن تترك أثراً في قلوب المعدمين والضعفاء؟، وقل مثل ذلك في حالات التبذير غير المبرر، وذلك كالإنفاق على لاعبي الكرة بما لا يخطر على بال، حتى إن بعضهم بلغ عقد استضافته عشرات الملايين، في وقت يتقاتل فيه آلاف الشباب على حفنة من الوظائف ذات المرتَّبات المتدنية، وبُحَّت أصوات كثير منهم وهم ينادون بتصحيح أوضاعهم، أو ترسيمهم، مع أننا لا نرى في الكرة التي تنفق لأجلها الملايين إلا مزيداً من الإخفاقات والفشل.
إن ولاة المسلمين مؤتمنون على الثروات، وهم عليها كالقاسم، ولذا فالواجب عليهم أن يصرفوها بحق وعدل، وأن يتحروا فيها ما يُصلح الناس، ويَصلُح للناس، وأن يعلموا أن الله سائلهم عنها يوم يقفون بين يديه، ولله در عمر الفاروق - رضي الله عنه - حين قال: "لو أن بغلة في العراق عثرت لعلمت أن الله سيسألني عنها"، فليعدوا للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، وإن من الجواب وصوابه أن تُساس المجتمعات بكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يكون الناس في الحقوق سواسية، وأن يكون شعار الحاكم والمحكوم " من أين لك هذا "، فإن كان من حقوق الناس أعيد إليهم، وإن كان مما أقدره الله على كسبه بالصفة الشرعية، فبارك الله له فيه، ورزقه وأعانه.
كما إن من الجواب والصواب، أن تتحمل القيادات مسؤوليتها بصدق، وألا تقهر الناس لتخرجهم عن طورهم، وتمارس في الوقت ذاته سياسة الاستفزاز البغيض، وتجعل شعارها "جوِّع ****ك يتبعك "، فإن الناس ليسوا كذلك، والإنسان المسلم وُلد حرَّاً، وهو يعشق الحرية فـ " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "، وإذا كانت الدول ترغب من شعوبها الوقوف معها حال الأزمات والشدائد، فكذلك الشعوب تريد من قياداتها الوقوف معها عند الرخاء واليسر.
إن الجموع المحتاجة المحتجة، التي ترى أن الوظائف لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد أن يموت دونها أعداد وأعداد، ثم يتنامى إلى سمعها أن امرأة أخذت معها طناً ونصف الطن من الذهب دفعة واحدة، فإنه لا يمكن أن تمنح الولاء والحب، ولا أن تلتمس العذر للحاكم مهما حاول الاعتذار.
ما الذي يضير هذه الدول أن تفتح المصانع الضخمة، بدلاً من تشييد الملاعب، وما الذي يمنع من إنشاء المراكز التدريبية المفيدة، بدلاً من إغراق المجتمعات بالمسارح والملاهي.
إننا حين نتحدث عن البطالة وأخطارها، وبلداننا تتربع على أعظم الثروات المعدنية والنفطية، وفي مقابل ذلك نستورد من الخارج كل شيء، وكأن عقول من نستورد منهم أنضج من عقولنا، ويجلس أبناء المجتمع ينتظرون دورهم في الوظائف الإدارية، أو بعض الوظائف الخدمية والعسكرية، حتى إذا تعذرتهم تلك الدوائر، وجدوا أنفسهم أمام فراغ قاتل، وفقر قاهر، فإن هذا يوجب علينا مراجعة السياسات والخطط، والالتفات إلى ما أودعه الله عندنا، والاستفادة من قدرات رجالنا وفتياتنا، وذلك من خلال الاهتمام بالمجال الفني والمهني، وإنشاء مراكز ضخمة للتدريب، ومصانع تستقبل هؤلاء المتدربين، وإتاحة الفرصة لهم للدخول في سوق العمل بقوة وثقة، ومنحهم الأولوية، وتذليل كل العقبات التي تحول بينهم وبين الاستمرار والمنافسة، ولعلي هنا أستشهد بنموذج واحد فقط يوجد لدينا في السعودية، وهو مراكز ومعاهد التدريب الفني والتعليم المهني، كم عمرها الفعلي؟، وكم الأعداد التي تخرَّجت منها؟، وما هو دورها في الواقع؟، وما أسباب تخلف المتخرجين عن المنافسة أو تطوير الذات؟، وأين ذهبت تلك الأعداد التي تخرجت؟، مع أنها كانت تتعلم مهناً لا غنى للناس عنها، كالحدادة، والنجارة، والكهرباء، والميكانيكا، والسمكرة، وغير ذلك مما لا نراه اليوم إلا بيد العمالة الوافدة، فهل كان التعليم لا يرقى للمنافسة؟، أم حال بينهم وبين المنافسة أسباب فنية؟، أم ماذا يا ترى؟.
على الدول أن تبدأ فعلياً بالاستفادة من الطاقات المهدرة، والمقدَّرات المبعثرة، وأن تفكِّر مليِّاً، وتبادر سريعاً، بإعادة ترتيب الصفوف، ومنع مظاهر الفساد والتفرقة، وأن تستشعر أن حرمان تلك المجتمعات من شيء تشعر أنها أولى به، سيولد عندها الاحتقان، وسيدفعها للانتقام، خاصة إذا بلغ الأمر حداً مزعجاً، أو وجد من يستغل ذلك الظرف، ثم ينفخ فيه النار.
بل يجب على ولاة الأمر أن يتحركوا لإصلاح مواطن الخلل كلها، وألا يقتصر العلاج على أمر المعيشة، وقضية البطالة، وغلاء الأسعار، بل يجب التحرك لإصلاح كل خلل يمس الضرورات الخمس، وأن يكون ذلك هو الشغل الشاغل، أما أن ينتظر الولاة حتى يغضب الناس، أو يصلوا إلى حدِّ الضجر، وبعدها يُفكرون بالتحرك واتخاذ بعض القرارات التخديرية، فهذا هو الغش بعينه.
وليس لأحد عذر في التبرير للبطالة بأنها موجودة في الدول المتقدمة، وأنها مشكلة عالمية، وذلك لأننا لم نضع حلولاً عملية للبطالة، بل اكتفينا بهذا العذر البارد، وإلا فلو كنا نمتلك المصانع، وننتج السلع، وقد اكتفينا ذاتياً، وأصبحنا نغزوا أسواق العالم بمنتجاتنا، فهنا يمكن أن نعتذر بالعالمية ومشاكلها، أما أن نستورد من الخارج معظم ما نحتاجه، مع أن بإمكاننا أن ننتجه هنا، فنحن والحالة هذه لا حجة لنا بما يقع عند غيرنا، ولعلي هنا أن أشير إلى قصة وقعت لي، حيث كنت مرة في سوريا، وعرض علي أحدهم زيارة مصنع للأحذية هناك، وذكر أنه لأحد أقربائه، وعندما ذهبنا للمصنع، وجدته لا يتجاوز في مساحته أربعة أمتار في ستة، وقد كنت أتصور أنه أكبر من هذا بمئات المرات، وقد كنت أضحك بيني وبين نفسي، وكنت أقول وأردد: مصنع! مصنع!، ومما زاد دهشتي ما ذكره صاحب المصنع من أنه يُصدِّر للسعودية، وأنه يشتري منه عدد من تجار الأحذية هنا، عندها وقفت وقفة صمت وحسرة، كنت أفكِّر معها وأقول: هذا المكان المتواضع، وهذا الجهد مع هذه العزيمة الصادقة، لو قام أمثالها في بلادنا، فكم ستستفيد منها من أسرة؟، وكم ستتاح فيها من وظيفة؟، وحتى لو أخفق بعضهم، أو تعثَّر في مسيرته، فما المانع أن تتاح أمامه الفرص، ويشجع ليقف على قدميه مرة أخرى.
إن شبابنا لا يقلون في مواهبهم، ولا في عقلياتهم، ولا في قدراتهم، عن غيرهم من سائر الشباب، لكنهم يجب أن يُصرفوا لما ينفعهم، ويستفاد من تلك العقول والمواهب والقدرات، أما أن تُترك لسهام التغريب والتخريب والتشويه والتشويش، من خلال القنوات، أو ما يروَّج من المخدرات، أو ما يُهيَّأ لهم من المغريات والملهيات، فهذا من الغش والخيانة، و ((من غشنا فليس منا)).
متى سنجد مدنا صناعية تستقطب آلاف الشباب، وتمنحهم فرصة العيش بكرامة، وتُكسبهم الخبرة والتجربة، وتجعلهم لبنات صالحة في المجتمع، وأعني بها المدن الصناعية الفعلية، وليست تلك المدن الأسطورية، التي رُصدت لها المليارات، وبقيت شاهدة باسمها، غائبة أو مُغيَّبة في حقيقتها وواقعها.
وإلى هنا أقف، وللحديث بقية، أستكملها قريبا بحول الله.
اللهم أعذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واعصمنا بالكتاب والسنة، واجعلنا من أنصار دينك، وحملة لواء شريعتك، والذابين عن حياضها.
اللهم عليك بالفجرة المنافقين، والخونة الليبراليين، والرجس العلمانيين، والرافضة المفسدين.
اللهم اهتك سترهم، وزدهم صغارا وذلا، وأرغم آنافهم، وعجل إتلافهم، واضرب بعضهم ببعض، وسلط عليهم من حيث لا يحتسبون.
اللهم اهدِ ضال المسلمين، وعافِ مبتلاهم، وفكَّ أسراهم، وارحم موتاهم، واشفِ مريضهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكسُ عاريهم، وانصر مجاهدهم، وردَّ غائبهم، وحقق أمانيهم.
اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك مؤيدا وظهيرا، ومعينا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وأمكنهم من رقاب عدوهم، وافتح لهم فتحا على فتح، واجعل عدوهم في أعينهم أحقر من الذر، وأخس من البعر، وأوثقه بحبالهم، وأرغم أنفه لهم، واجعله يرهبهم كما ترهب البهائم المفترس من السباع.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا.
اللهم أصلح الراعي والرعية.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، واحفظ عليها دينها، وحماة دينها، وورثة نبيها، واجعل قادتها قدوة للخير، مفاتيح للفضيلة، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إن نسوا، وتعينهم إن تذكروا، واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، يا سميع الدعاء.
هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.




 المنتديات العامة
المنتديات العامة 





