
إن القضية قبل أن تكون اعتناقاً لفـكر
أو اقتـناعاً بمـبدأ؛ هي قضـية إيمـان وتسـليم
فمن الحقـائق المقـررة
في ديـننا أن الله لم يتـرك منـاهج
إصـلاح البـشر للبـشر بشكل مطـلق
بل تولى ـ سبحـانه ـ ذلك بنفـسه
فأرسـل لذلك الرسـل وأنـزل الكتب
ونادى الوحي في الناس جميعاً:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا *
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}
[النساء: 174 - 176]
وإن الظن بأن البشر يمكنهم التفرد بتدبير شؤونهم
بما يتفق مع غاية خلقهم، هو سوء ظن بالإله الخالق ـ سبحانه ـ
وادعاء عليه بالعبثية وعدم الحكمة ـ جل ربنا عن ذلك ـ
إذ كيف يخلق ويرزق، ثم يأذن للإنسان بأن يفسد باسم الإصلاح
أو يفجر باسم التحرر...؟
{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ *
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ كَالْـمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْـمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ *
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}
[ص: 27 - 34].
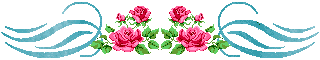
والفكر الليبرالي (Libralisme)
لم يبلوره مفكر واحد في عصر واحد
بل اشترك في وضع أصوله العديد من المفكرين في أزمنة وأمكنة مختلفة
حتى صارت له أسسٌ تشمل نواحي الحياة في جوانبها
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية
إلاّ أن هذا الشمول لا ينفي عن الليبرالية صفة القصور
لأنها اقتصرت في الجملة على تلبية الغرائز الدنيا في الإنسان
دون أدنى اعتبار للقيم العليا التي من أجلها كرّم الله بني آدم
وحملهم في البر والبحر وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً
بل هي فوق ذلك لا تعتمد إلا على أخس قدرات الإنسان على الفعل
وهي التمرد على إرادة الله عن طريق الكسب الاختياري الذي منحه إياه:
{بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ}
[القيامة: 5 - 6]
وهذا هو أحط أنواع العبودية لغير الله
حيث يجعل من نفسه إلهاً لنفسه.
لقد نشـأ الفـكـر اللـيبرالي في بيئة غير بيئتنا
وتأصل على غير شريعتنا وأخلاقياتنا
وطُبق في غير مجتمعاتنا
واستهدف علاج آفات وإصلاح عيوب لم تعانِ منها أمتنا
فليس عندنا تسلط كنسي على عقول الناس
ولا احتكار كهنوتي للحقيقة
ولا خرافة طقوس تقوم على الخصومة المفتعلة بين الدين والعلم
ومع هذا، هَامَ به ـ على طريقة جُحر الضب ـ أقوام من المسلمين
وأرادوا أن يستوردوه ومعه العز والتقدم والشرف
فلم يجرُّوا بذلك على أمتهم إلا الذل والتأخر والانكسار
وصعب عليهم بعد ذلك
ـ كما فعل الغراب حين أراد أن يقلد مشية الهُدْهُد ـ
أن يعودوا لما كانوا عليه، فلا هم ظلوا مسلمين صلحاء أنقياء
ولا هم صاروا غربيين خلصاء بل:
{مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلَى هَؤُلاءِ وَلا إلَى هَؤُلاءِ}
[النساء: 143].
نشأ الفكر الليبرالي عن فلسفة سياسية واقتصادية
أفرزت قناعات ثقافية وممارسات اجتماعية
حاولت بعد ذلك أن تتحول إلى منطلقـات لحـريـة ديـنية
ونـسبية اعـتقادية، تؤول إلى (اللا دين).
والليبرالية، بكل تعريفاتها لكل أصنافها
تركز على جوهر واحد يتفق عليه جميع الليبراليين
وهو أنها:
تعتبر الحرية هي المبدأ والمنتهى في حياة الإنسان
وهي وراء بواعثه وأهدافه
وهي المقدمة والنتيجة لأفعاله
فالحرية هي سيدة القيم عندهم دون أدنى حدود أو قيود
سواء كانت هذه الحدود هي (حدود الله)
أو كانت تلك القيود لسبب سياسي أو اجتماعي، أو ثقافي
أما مبدأ عبودية الإنسان لخالقه كما جاءت به رسالات السماء جميعاً
فهي عند الليبراليين لون من تراث الماضي «المتخلف».
الليبرالية... وتأليه الهوى:
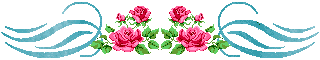
يدرك من له أدنى إلمام بتصنيفات وتفريعات أصحاب الـملل والنحل والأديان
أن الإنسان بمعزل عن هداية الوحي
عبد كل شيء من حجر وشجر وشمس وقمر
وقدَّس الكثيرَ من الحيوان والهوام
وأطاع كل طاغوت من إنسان وجان
إلا أن هناك عبادة أخرى لم تشتهر بين العبادات
لأن المعبود فيها غير مشخـص ولا ثابت
والعبادة فيها بلا شعائر ولا طقوس
ألا وهي عبادة الذات وتقديس الهوى
وتلك العبادة تختلف عن غيرها
بأن العبودية فيها غير واضحة المعالم
فهي مجرد سير أعمى وأهوج في طرق مظلمة
بحثاً عن سعادة مفقودة
وغاية غير موجودة.
وهذا الظلام الحالك، هو ما أشار إليه القرآن في قول الله ـ تعالى ـ:
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً
فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ}
[الجاثية: 23]
ففي الآية تنديدٌ بمن يأتمر بأمر هواه؛ فما رآه حسناً فعله
وما رآه قبيحاً تركه، وهذا هو جوهر التأليه
فكل ما يستلزم الطاعة بلا قيود فهو عبودية
والإله المعبود في الآية هو الهوى، من باب التشبيه البليغ أو الحقيقة
والطاعة هنا مستلزمة للمحبة والرغبة
فـ (هواه) بمعنى: مهويه ومرغوبه المطاع.
ولهذا فإن عِلْم عابد الهوى لا ينفعه إن كان عنده علم
لأن الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
فلا هادي له ولا مرشد من بعد الله
لأنه أغلق على نفسه باب الهداية عندما عزل نفسه بنفسه عنها.
ولم نرَ في الأفكار والمناهج المنحرفة شيئاً
ألصق بوصف عبادة الهوى وتقديس الذات مثل الليبرالية المعاصرة
من حيث وضعها وتعريفها
فهي تعني طلاقة حرية الإنسان وانفلاتها من كل القيود
بحيث لا يكــون هنـاك أي مانـع أو رادع
مـن فـرد أو أسرة أو جماعة أو دولة أو فكر أو دين أو تقاليد
بل يتصرف المرء وفق ما تمليه النفس وتسوق إليه الرغبة
على ألا يتعدى على حرية الآخرين.
صحيح أن أرباب الليبرالية يختلفون فيها بقدر اختلاف أهوائهم
إلا أنهم يتفقون على شيء واحد
وهو وصف موسوعة (لالاند) الفلسفية لها بأنها:
«الانفلات المطلق بالترفع فوق كل طبيعة».
وقد عرَّفها المفكر اليهودي (هاليفي) بأنها:
«الاستقلال عن العلل الخارجية، فتكون أجناسها:
الحرية المادية والحرية المدنية أو السياسية
والحرية النفسية والحرية الميتافيزيقية (الدينية)»
وعرفها الفيلسوف الوجودي (جان جاك روسو) بأنها:
«الحرية الحقة في أن نطبق القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا».
وعرفها الفيلسوف (هوبز) بأنها
«غياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء».
وهكذا نرى أن تعريفات الليبرالية تُجمِع على أنها انكفاء على النفس
مع انفتاح على الهوى؛ بحيث لا يكون الإنسان تابعاً إلا لنفسه
ولا أسيراً إلا لهواه
وهو ما اختصره المفكر الفرنسي (لاشييه) في قوله:
«الليبرالية هي الانفلات المطلق».
ولهذا فإننا نعجب كل العجب
ممن لديه أدنى معرفة بمعنى العبودية لله في الإسلام
كيف يجرؤ أن يقول:
(الليبرالية الإسلامية)
فيجمع بين مـتنـاقضين
وهل يمكن أن ينادي مـن أسـلم بـ «انفـلات مطـلق»
أو «تطبيق للقوانين التي اشترعها الإنسان بنفسه لنفسه»؟!
وهل هناك في الإسلام استقلال عن كل المؤثرات الخارجية
في الاعتقاد والسياسة والنفس والمادة؟!
كيف يمكن أن تنسب كـل هـذه القبـائح للإسلام أو تصبغ به؟
إن الليبراليين الـغربـيـين يحـلو لهم كثيراً
أن يكسوا هذه الدمامة بأصباغ من الجمـال المصطنع
فيفلسفوا اتِّباع الهوى بـ
«تحكيم العقل»
ويصـفـوا التـمـرد على القـيم والـثوابـت
بـ «الحرية المطلقة» أو «منع المنع»
ويرددوا دائماً بأنهم ضد الاستبداد السياسي الذي يمثله استبداد الدولة
والاستبداد الاجتماعي الذي تمثله القيم والأعراف
والاستبداد الديني الذي تمثله العقائد.
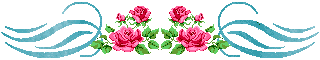
ولذلك نرى الليبراليين بكل أصنافهم ينفرون من كلمة (ثوابت)
ويضيق عَطَنُهم من كلمة (عقيدة)
ويفرون كأنهم حمرٌ مستنفرة فرت من قسورة
إذا حدثتهم عن ثبات الأحكام، ودوام الحكمة والصلاحية فيها.
وبالنظر إلى أن طبيعة الهوى وسجية أهل الأهواء هي التقلب والتغير
فقد صاحَبَ الغموضُ مصطلحَ (الليبرالية) في مرحل تطورها
إلا في أمر واحد؛ وهو: تحقيق الرفاه والترف والذاتية الفردية إلى الحد الأقصى
وتحول هذا من الإطار الذاتي إلى الإطار الجمعي لدى المجتمعات
التي تبنت الأفكار الليبرالية
والتي أسمت نفسها (العالم الحر)
وأصبح هذا العالم (حراً) في أن يحقق الحد الأقصى من الرفاة والمتاع
سيراً وراء الهوى المتبع والشح المطاع للأفراد
كل ذلك على خلفية المصلحة
المرادفة في كل الأحوال للأنانية المفرطة.
ولهذا وجد الناس البَوْن شاسعاً بين شعارات الليبرالية في عالم المثال
وتطبيقاتها في عالم الواقع؛ فقد غاب العامل الإنساني
وحل محله العامل الطبقي أو العنصري
ولم يعد (الإنسان) هو قضية الليبرالية الأولى
إلا بحسب لونه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي
فالليبرالية السياسية (الديمقراطية)
في الغرب تختلف عن ديمقراطيات البلدان التابعة أو المستعبَدة من الغرب
والليبرالية الاقتصادية (الرأسمالية)
في الغرب يجب أن توصِل عندهم إلى نتائج مسيطِرة
وعندنا إلى نتائج مسيطَر عليها.
وأما بقية مفردات الليبرالية من ثقافية واجتماعية ودينية
فهي ينبغي أن تمثل عندهم نموذج القدوة والمثال
بينما تمثل لدى مقلديهم أنماط التبعية والذوبان إلى حد الابتذال.
أما الليبرالية الفكرية الثقافية والدينية فهي الأخطر
وتعني عندهم المزيد من هجر الخصوصيات والثوابت عند الأمم
في حين يفيئون هم إلى ما يعدُّونه قِيَماً يجب تصويرها بأحسن صورة
وتصديرها على أوسع نطاق.
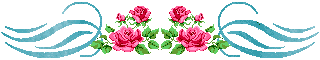
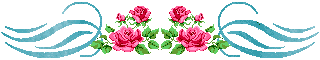




 المنتديات العامة
المنتديات العامة 











