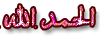 عثرت على مكتبة رائعة بها امهات الكتب فى كل المجالات وسأحاول ان شاء الله وبتوفيقه ان اتقل اليكم بعض من هذه الكتب لتكون فى ارشيق المنتدى بين ايديكم عندما تريد وتحب ان تقرأ شيئا نافعا واليوم سأنقل لكم كتابا عن السلفية وهم الان فريق صار واقعا سياسيا فنحن جميعا سلفيون ولكن ما علمته انهم فرق كثر ومناهج عديدة اراد كاتب هذا الكاتب ان يلقى الضوء على احد هذه الفرق اتركم الان مع الجزء الاول من كتاب (هى السلفية
عثرت على مكتبة رائعة بها امهات الكتب فى كل المجالات وسأحاول ان شاء الله وبتوفيقه ان اتقل اليكم بعض من هذه الكتب لتكون فى ارشيق المنتدى بين ايديكم عندما تريد وتحب ان تقرأ شيئا نافعا واليوم سأنقل لكم كتابا عن السلفية وهم الان فريق صار واقعا سياسيا فنحن جميعا سلفيون ولكن ما علمته انهم فرق كثر ومناهج عديدة اراد كاتب هذا الكاتب ان يلقى الضوء على احد هذه الفرق اتركم الان مع الجزء الاول من كتاب (هى السلفية)
إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَستعينُهُ
ونَستَغفرُهُ، ونَعوذُ بالله مِن شرورِ أنفُسِنا، ومن سَيِّئاتِ أعمالنا، مَن
يَهدِهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِل فلا هادِيَ لهُ.
وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وَحدَهُ
لا شَريكَ لهُ.
وأشهَدُ أنَّ محمداً عَبدُهُ
ورَسولُهُ... أما بعد.
فهذا كتابٌ مُهمٌّ أوفى عَلى تَجربةٍ
قامَت على سُوقِها بَعد نَيِّفٍ وثلاثينَ عاماً، ما بَخِلتُ فيه بشيءٍ مِمَّا
أعلَمُ أنَّهُ حقٌّ، يُجْبى إليه مثلُهُ – بالنَّظَر المُتأمِّل، والبَصرِ
المُتَعمِّق – مِمَّا يُشبهه، مِمَّا يَجري في حياةِ أُمَّتنا اليَوم، أو مِمَّا
سَيَجري فيها من غَدٍ، غيرَ راجٍ به إلاَّ وجهَ الله واليومَ الآخِرِ، فإنْ سألني
الله عزَّ وجَلَّ – وهو سائِلُني – هَل نَصحتَ للأُمَّةِ في أمرٍ عَلِمتَهُ، فكان
من النَّاسِ حيالَه ظالمٌ لنَفسه، ومُقسطٌ، وسابقٌ بالخَير؟ فيكونُ رجائي أن أكونَ
– إن شاءَ الله – مِن السَّابقين بالخَير، والله عندَ حُسن ظَنِّ عَبدِهِ بهِ، إذْ
لم أكتُم الأُمَّة شيئاً مِمَّا علمتُهُ حقَّاً فأسديتُ به نُصحاً لها، أو مِمَّا
علمتُهُ باطلاً، فكان تحذيرٌ منِّي لها، والله شاهدٌ على ذلك.
وقد جَعَلتُ هذا الكتابَ في عَشرةِ
مباحِثَ، بَيَّنتُ فيها منهجَ الدَّعوة السًّلفية([1])،
وشرحتُ فيها قواعِدَها وأُصولَها، وَرَددتُ على المُشكِّكينَ بها، الطَّاعنينَ
عليها، وأظهَرتُ ما تُخفيهِ نفوسُهُم من الحَسَدِ والمَكْرِ بها، أو الجَهلِ
بِحَقيقتِها، ولَبَّيتُ فيه رَغبةَ الكثيرينَ من إخوانِنا وأصحابِنا، نُصرَةً
لحَقٍّ، وكَشفاً لباطلٍ، وذَبَّاً عن دَعوةٍ أقامَها الله على عَمودِ النُّور.
ولا إخالُ مسلماً إلاَّ وهو في حاجَةٍ
إلى هذا الكتاب، مُحباً كان أمْ باغِضاً، ليزدادَ المُحبُّ حُباً، ويَعرفَ
الباغِضُ أينَ هو بِبُغضِهِ من هذه الدَّعوةِ المبارَكةِ، التي أظَلَّت الدُّنيا
زَماناً، وستُظلُّهُ مُستَقبلاً إنْ شاءَ الله، بأفيائها الظَّليلَةِ إلى أن يَرثَ
الله الأرضَ ومَن عليها، وذلك وعدُ الله؛ ولَن يُخلفَ الله وعدَهُ([2])،
{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ } [سورة الصف: اّية 9].
والله سبحانَهُ أسألُ، أنْ يَهديَنا
بِنورِهِ إليه، وأنْ يُلزمنا كلمَةَ التَّقوى، ويَجعلنا أهلَها المُخلصين،
الرَّاجين رَحمتُه، الخائفينَ عذابَهُ، إنِّه سَميعٌ قَريبٌ مجيبٌ.
وقـد كـان الفــراغ منه
ليلةَ السَّابع والعشرين من رَمضان /
عام 1412هـ
الموافق
التَّاسع والعشرين من آذار / عام 1992م
والحمدُ
لله الذي بنعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحات
{رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [سورة النمل: اّية
19].
كتبه
محمَّد إبراهيم شقرة
عمَّان – الأردن
توْطِئـَــة وَبيــان
فقد
كَثُرتْ في الآوِنَةِ الأخيرةِ الأحاديثُ – إمَّا بِجَهلٍ جاهرٍ، وإمَّا بسوءِ
قَصدٍ جائرٍ – عَن السَّلفيَّة والسَّلفيِّين، حتى صارَت بهذه الأحاديث، موضعَ شكٍّ
وريبةٍ، لدى كثير من أهل السِّياسةِ، يَخافونَها في أنفُسِهم خوفاً شديداً،
وَيَخشونَها كَخَشيتهم أعداءَهُم أو أشدَّ خَشيَةً، ويَتربَّصونَ بها الدَّوائرَ،
لظنِّهم أنَّها مُوقعةٌ بهم شرَّاً، أو مُنزلةٌ فيهم نُكراً!
وزاد
مِن شكِّهم وريبتِهم، ما وقعَ في بَعضِ الأقطارِ الإسلاميَّة مِن أحداثٍ، نُسبَت
زوراً وبُهتاناً إلى الدُّعاةِ السَّلفيِّين – وهم منها والله براءٌ براءةَ
الذِّئب من دمِ يوسُف – وصل بعضها إلى حدِّ استِباحَةِ الدِّماءِ، واكتفى بعضها
الآخر بالمناوَشة من مكانٍ بعيد، تَختفي حيناً، وتَظهَرُ حيناً، ورُبَّما صاحَبَ الحالَين
حَذرٌ شديدٌ من طرَفين، يَلِجَّانِ في خُصومَةٍ في آنٍ معاً، وكلٌّ منهما يتربَّصُ
بالآخر خَتْلاً، أو ريبةً، أو مِراءً، حتى إذا أصابَ منهُ غَرَضاً أنفَذَ سهمَهُ
فيه، لا ليُدميَه، بل لِيَصْمِيَه!!
لكنَّ
الأمرَ في كل هذه الحالات لا يجاوز دائرة الحَذَر، ثم لا يُخرجْ أضغاثَ الأحقادِ
من الصُّدور ، فتَظلُّ مُستَتِرةً، حتى إذا أصابَتها شرارةٌ واحدةٌ اشتَعلَت
وأشعَلَت، واحتَرقَت وأحرَقَت، وكان حَصادُها: رؤُوساً، وأرواحاً، ودماءً،
وأموالاً مَهدورةً، وثاراتٍ مَوتورَةً، وبيوتاً مَهجورةً، وإحَناً مَسعورَةً،
وعداواتٍ ظاهرَةً ومَستورة – عياذاً بالله -!!
ثمَّ ومع هذا الاختلاط، وغياب العقل
الواعي، وبترِ اليد السَّديدة الرَّحيمة، وتَداخُل الأشياءِ والأحداثِ، حتى لا
يكادَ يُعرَفُ منها حدثٌ يُنسَبُ إلى طرف ما، نِسبَةَ علم ويَقين، لا تَجِدُ مَن
يَتَّقي الله من أولئكَ الذينَ يتَربَّصونَ بالمُسلمينَ الدَّوائر – حتى إنَّهُم
ربما كانوا مِن المُسلمين أنفُسهم – فيقول قَولَةَ صِدقٍ، لا يَتَّهمُ طَرفاً دونَ
الآخرَ، أو يُدينهُ، بل إنَّهُ لَيُفوِّقُ سهمَهُ، ويُوتِّرُ قَوسَهُ، ثمَّ يرمي
به طرَفاً واحداً، مَشحوناً بِحقده على الدِّين والعَقيدة، فيَزيدُ بذلك من إشعالِ
نارِ العَداوَةِ، ويوقظُ في النُّفوسِ حِسَّاً خامِداً، يُمدُّهُ أحدُ الطَّرفين
متى شاءَ، لتَدمير جسور المَودَّة، والتَّعاونِ، والقَرابَةِ، والجوارِ، ويَومئذٍ
يَفرح المُجرمون الآثمونَ، ويَرقُصونَ طَرباً على مزامير الشيطان، أليسَ قَد
حقَّقوا ما يُريدون؟! وكان لهم من الشرِّ والفسادِ، والخرابِ، والتَّدمير ما
يَبغون؟
ولقد ظُلِمَت السَّلفيَّة قَديماً
وحديثاً ظُلماً شديداً من أوليائها ومِن خُصومِها معاً، ما ليس في طَوقِ البشرِ لو
اجتَمعوا على كلمةٍ واحدةٍ، أن يَنصروا أنفُسَهم إلاَّ أن يكونَ فَصلُ العَدل فيه
لله وحدَهُ سبحانَهُ، يومَ يقومُ الأشهاد، وتَذوبُ الأبعاد، ويقف فيه أمامَ
الميزان العِبادُ.
بيد أنَّه لا بُدَّ من دَفعِ الظُّلمِ
بالحُجّةِ والبُرهان، ما استَطَعنا إلى ذلك سبيلاً، فإنَّ نُصرَة الحَقِّ واجبةٌ،
ومظاهرةَ أهل الحقِّ أوجَبُ وأوجَبُ، إذ الحقُّ ظاهرٌ بنَفسِهِ جليٌّ، وهو لو
تَبدَّى وحدَهُ – بلا نَصيرٍ ولا ظَهيرٍ – لكان تَبدِّيه يَكفيه نَصيراً وظَهيراً،
أمَّا أهلُ الحقِّ فَقَد نُوزعوا في الحقِّ قديماً ولا يَزالون، وكان مِن عداوَةِ
أهلِ الباطل لهم لباساً، وشَّاهُ أهلُه بزُخرفِ القولِ، وزور العلم، فأهاجوا عليهم
العامَّة، وناصرُوا عليهم أهلَ الجَوْرِ من ذوي الرِّياسة والسُّلطان، وأركَضوا
كلَّ آثامهم نَحوَ دورهم، وبيوتهم، ومساجدهم، ومدارسهم، لم يَختلف لهم وجهٌ، ولا
لَونٌ، ولا شكلٌ، في زمان دون زمان، وهل عُلِمَ أهل سوءٍ، إلاَّ وباطِلُهم قَد
كُوِّرَ على ليلٍ بهيمٍ، لا مكان لحقٍّ فيه، وإن ظُنَّ أنَّ حقاً يكون فيه، فلا
يُبصر فيه!!
وتناوَلتُ في هذا الكتاب بعضَ القضايا
والمسائل، التي تدور في فَلَك السَّلفيَّة، مِن غَيرِ قَصدٍ إلى تَرتيب مُعيَّن،
ولا إلى نظام عرفهُ المؤلِّفون والكُـتَّاب والباحثون، مِن خلالِ تَجربةٍ
عِلميَّةٍ عَمَليَّةٍ، امتَدَّت سنين كثيرةً، لم يكن في حسابي يوماً، أن أجدني
قاضياً على نفسي بتجربةٍ، ولا على غيري بِحُكمٍ، قَد يَروقُ بعضاً، ولا يَروق
بعضاً آخر، وإن كان يَجدُرُ القول: إنَّ حكم الإنسان على نَفسِهِ، بما يَعلم منها،
أصدَقُ وأصوَبُ مِن حُكم غيره عليه، وبِخاصَّة فيما يَتَعلَّقُ بالأعمال
القلبيَّةِ التي لا يَعلمُها إلاَّ الله وحدَهُ منه، وحينَ يحكُم الإنسان على
نَفسِهِ بِمثلِ ما وَصفنا، يكون أقدَرَ على تَغيير ما يَراه مِن نَفسِهِ خطأً.
إذاً: فَثُلْثُ قَرنٍ من الزَّمَن –
جَاست خلالَ سنواتِهِ تجربةٌ، حَمَلت صاحِبَها على كفِّها راضيَةً مُطمئنَّةً،
واثقةً من صدقِهِ في إقبالِهِ إذ أقبل، وإن خُيِّلَ لِبَعضٍ – من أصحابنا وإخوانٍ
لنا – بأنَّه كان له إدبار(!) فعاجَت بهم الظُّنون عَوْجَ مَن لَقِفَ قَلْبُهُ
أمراً يُحدَّثُ به، غَيرَ مُتَثَبِّتٍ ولا مُتأنٍّ، وكأنَّهُم لم يَقرءُوا قوله
سبحانُه:
{وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ الله} [سورة الأنفال: اّية 16]، كافٍ([3])
في سَبرِ هذه الدَّعوة المُباركةِ، واستظهار حقيقتها، وبناء قناعةٍ مُستَقرَّةٍ،
لا يُقبَل غيرها!!
وليسَ مَطلوباً من إنسانٍ – أيِّ إنسانٍ
– وهو يضع نَفسَهُ تحتَ ظُلَّةِ القَضاءِ، يَحكُم على نَفسِهِ بِنَفسِهِ، أن
يُظهِرَ خَفايا صَدرِهِ، ومكنونَ قَلبِهِ، ومستورَ ذَنبِهِ، ومَن مِن البَشَر ليسَ
يُخفي في صَدره، ويُكنُّ في قلبه، ويستُر على نَفسه من ذَنبه؟! وليسَ في هذا شيءٌ
من تَزكيةِ النَّفس، بل هو مِمَّا يزكِّي به الله سبحانهُ عَبدَهُ الصَّانِعَهُ،
والله سبحانُه هو وحدَهُ العليمُ الخبيرُ، المُوفِّق للخَير الذي يَرضاهُ
لِعبادِه.
وحينَ يكون الحُكم على منهج، آمن به
المَرءُ، وآثرَهُ على كلِّ ما سواهُ، صدَّقَهُ وأحبَّهُ، فإنَّ الأمرَ مُختلفٌ
جداً، إذ الحُكمُ عليه عند مَن آمن به وصَدَّقه، لا يَقبَل إخضاعَه للنَّظَر
العَقليِّ، والسَّبْر، والاستقصاءِ، والتَّرجيح، وهو يُقارَن بغَيره.
وإذا كان هذا يَصْدُقُ على كلِّ منهج من
مناهج الأرض التي تَواضَعَ عليها البشرُ، فإنَّه لا يَصْدُقُ على المنهج الذي
ارتضاهُ ربُّ البَشرِ للبَشرِ.
ومن أخضَعَ هذا المنهج لهذا النَّظَر،
فقد أخَذَ بِخطامِ نَفسِهِ إلى مباءةِ إثم، وساقَها إلى مُنحَدرِ هَلاك، وحَمَلها
على غَضبٍ من الله وعقاب.
ولو أنَّ أهل العلم في كلِّ عَصرٍ،
استبصروا الحقَّ واستنطقوه، وأحلُّوا
أنفسَهُم منه مكاناً لا ظِنَّة فيه ولا امتراء، لرَأوا أنَّه يَقضي عليهم؛
بأن لا يُبصروا إلاَّ ذلك المنهج الأبلج الأبهج، أمام أعينهم، فلا يَضِلُّ عنهم،
ولا يُضِلُّون أنفسَهُم عنه، وكيف يَضِلُّ هو أو يُضَلُّون عنه، وهو الذي تداعَت
إليه القرون، وذلَّت له الشِّعاب الحُزون، وانقادَت إليه كلُّ سَهْلَةٍ وحَرونٍ؟
ولا أدري كيف، ولا لماذا أنشأ أعداءُ
هذا المنهج عداوتَهم في صدورهم، ونشَّأوا قلوبهم في بُغضِه، وتنافَسوا في المَكرِ
والكَيدِ له ولأهله، وألَّفوا الكتب والرَّسائلَ في تَشويه وجهِه، وتَنفير النَّاس
منه؟
نَعَم؛ قَد يَجدُ المَرءُ العَدلُ
البَصيرُ عُذراً في مثل هذا الصَّنيع، فيمن وجَدوا أنفسَهُم – بعلمهم – موثوقين
بِرُممٍ مُحكَمةِ الفَتلِ، إلى جذوع الضَّلالِ والجَهلِ، تَنزعُ بهم إلى أسناخِ
الرَّفض الباطنيِّ، والزَّيغ الاعتزالي، والغَولِ الفَلسَفيِّ، فيَنفضُ منهم يديه،
ويُعَزِّي نفسه أن لو كانوا يعلمون الغَيب، ما ألبثوا أنفسهم، ولا أقاموها في
البلاء المُبين، الذي نَسجوا رِداءه الخَشِنَ الغَليظَ لأنفسهم بأنفسهم هم!!
وقد أعانَ هؤلاءِ على صنيعهم هذا، ما
يقع في بعض الأحيان بينَ بعض مُلتزمي هذا المنهج، مِن خلافٍ، وصِدامٍ، وقطيعةٍ، إن
أحسَنتَ الظَّنَّ بهم في ما أجرَوا على أنفسهم، وأجازوه لها، مِن خلافٍ، وصِدامٍ،
وقطيعَةٍ، فلا يَعدو أن يَكونَ منشؤهُ تنافُساً بينهم – لطبيعتهم البشرية – على
أمورٍ دُنيويَّة، ليسَ فيها حتى مِن رَغبةٍ لعمل الآخِرَة!
ثمَّ لا يَلبَثُ أن يُحَوِّلوه بتَزيين
النَّفس له ولها، إلى خلافٍ في حقٍّ وفي باطل، فهذا يَرى نفسه بأنَّهُ على حقٍّ لا
شِيَةَ فيه، وأنَّ الآخَرَ على باطل لا شائبةً من حقٍّ فيه، والآخر يُري نَفسَهُ ما
أرى خصمه نفسه، ويذوب الخلاف على أمور الدُّنيا في الظَّاهر، والصُّدور مستَعرةٌ
بغضاءَ وكراهيةً وتربُّصاً بالشرِّ، عياذاً بالله تعالى، ويحيكونَ – كل للآخَر –
ثوباً مِن هذه البَغضاءِ والكراهية والتَّربُّصِ بالشرِّ، والفائزُ منهم هو
الأسرعُ بإلقائه الثَّوبَ الذي حاكه على الآخر، ولا يذكِّرُني هذا الصَّنيع، إلاّ
بمُبارزات رُعاة البَقَر، وبها وَحدهَا فقط، فالرَّصاصةُ التي تَنطلقُ أولاً هي
القاتلة، وهي التي تُنهي المُبارَزَة!!!([4])
لهذا فإنِّي أقول دائماً: البَيتُ لا
يخرب بالفؤوس والمعاول التي تعمل فيه هدماً من الخارج، بل من المسامير والأوتاد
الصَّغيرة، التي تُدَقُّ فيه مِن الدَّاخل!!
وعليه؛ فلا يَنبغي أن يَعيب
السَّلفيُّون – فَقط – على مَن يَحمل في قلبِهِ الضِّغن، والبَغضاء لهم، بل
يَنبَغي لهم – أيضاً – أن يُفَتِّشوا عَن العيوب في داخلهم، وأن يقولوا حُسناً:
العيبُ فينا أوَّلاً، وَلْنُفَتِّش عن العيب في أنفسنا لنعلمَهُ منها قبلَ أن
يعلمَهُ الآخَرون فنُصلحَهُ! فذلك: أحرى أن يَصدَّ عنهم شَرَّة الوِغادة واللُّؤمِ
التي تَستَقرُّ حُمَّاها في صدورِ خُصومهم.
وهذا الكتابُ، تَحكي صَفحاتُهُ تَجربةً
مَنَّ الله بها عَليَّ زُهاءَ ثُلثِ قَرنٍ، رقَّت فيها حواشي النَّفس، وسمتْ فيها
خواطِرُ القلبِ، وترسَّخَت فيها حقائقُ الإيمان والتَّوحيد الحقّ، ونَبَتَت فيها
غِراسُ العلم، وضَعُفَت فيها رغائب الآمال، وقَصُرَ فيها غَرْبُ الشهوات،
وانبَجَسَت فيها عيونُ المَعرفَة، وأبصَرَت العَينُ فيها قذاها، ورأت أردية العجز
تضطربُ على سيقان الأماني، الجارية في خمائل التَّقوى، فأمسكتْ بها وهي تفوحُ بشذا
عَرْف الجنَّة، فَغَمرتها، وغابت في ثنيَّاتها، تُصبحُ وتُمسي، و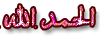 على
على
آلائه، والشكر له على نعمائِه.
وكُنتُ أوَدُّ - وهو أحبُّ إليَّ من
وجهٍ - أن لا أستعمل كلمة السَّلفية والسَّلفيين، خشية أن أُرمى بما كنت عِبتُهُ
على الجماعات والحركات الإسلاميَّة، قبل سنين خَلَت في مقالٍ لي بعنوان: «إنْ هي
إلاَّ أسماءٌ فرَّقَت فَدَعوها»، وإن كنت قد بيَّنت في مقال لي آخَر بعده بعنوان
«لا دفاعاً عن السَّلفية»([5])
ما تَعني هذه الكلمة، ومِمَّا كتبته في ذلك المقال: «وأوَّلُ ما يجبُ أن نعرفه
معنى السَّلفية، فهي كلمةٌ، تَنفي بمعناها المُتبادِرِ منها - أيَّ مَعنى يدلُّ
على حركةٍ سياسيَّةٍ، أو جماعةٍ حزبيَّةٍ، أو تَكتُّلٍ مُتطرِّفٍ غالٍ، فهذه
كلُّها ومثيلاتُها لا مَوردَ لها إلى كلمة (السَّلفيَّة) ألبتَّة، فمن فهم غَير
ذلك، أو أُفهم غَير ذلك، فإنَّه مُخالفٌ ولِنَهج السَّلفِ غيرُ سالك، إنَّما
السَّلفية دعوةٌ فِطريَّةٌ محوطَةٌ بأُخوَّة حقَّةٍ، وتَعاوُنٍ صادِقٍ، فهل لأهلها
أن يعرفوا ذلك؟!
وإذا رَددنا هذه الكلمة إلى اللُّغة
ومقاييسها، فإنَّنا واجدونَ أنَّها مَصدَرٌ صِناعيٌّ، والمصدَر الصِّناعيُّ،
تَلحَق بآخِرة ياءُ النِّسبةِ مع اقتِرانها بالهاء، يُسكَتُ عليها حينَ الوقفِ،
وتُقلَبُ تاءً في الوَصل.
ولا يَخفى على عاقلٍ، أنَّ كلمة
«السَّلفِيَّة» إنَّما تعني النِّسبة إلى السَّلفِ الصَّالح رضوان الله عليهم،
والسَّلف «كلُّ عمل صالح قدَّمته، أو فرطٍ فرطَ لك، وكلُّ من تقدَّمك مِن آبائك
وأقربائكَ»، هذا هو المعنى اللُّغويُّ لكلمة السَّلف.
وأمَّا في ما اصطلَح عليه جماهيرُ أهل
العلم فهو:
مَن تقدَّمنا من هذه الأمَّة، وبخاصَّةٍ
القرون الثلاثة الأولى، وكانوا على مِنهاجِ النُّبوة، الذي جاءَ به الوحيُ، ونزلَ
به، وبلَّغهُ كما وعاهُ عن ربِّه، نبيُّه محمد صلى الله عليه وسلم.
وهو اصطلاحٌ قديمٌ، لم يكن من وَضع مَن
أصبحوا يُعرَفونَ به ابتداءً، وهذا فرقٌ عظيمٌ ما بَينَ مَن ينتسبون إلى هذه
النِّسبة الشريفة، وبينَ مَن يَتَسمَّونَ بأسماء أخرى مِن الجماعات والحَركات
الإسلاميَّة، التي وضع أسماءَها مُؤَسِّسوها.
ولستُ أحسبُ أحداً مِن المُسلمين يَعرف
هذه النِّسبَةَ على حقيقها، إلاَّ وهو يَعلمُ أنّها نسبةٌ إلى الإسلام كلِّه،
بأحكامِهِ وآدابِهِ، وأخلاقِهِ وعقيدَتِهِ، كما أمَرَ الله سبحانهُ {يأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [سورة البقرة: آية 208]،
وكما أمَر نبيُّه صلى الله عليه وسلم: «عليكُم بسنَّتي وسُنَّة الخُلفاء المَهديين
الرَّاشدين مِن بعدي، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكم ومُحدثاتِ الأمور، فإنَّ
كلَّ مُحدثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةُ»([6]).
والسَّلفية
بهذا المعنى، ليسَت حِكراً على فئة من النَّاس، عُرفوا بهذه النِّسبة، إمَّا من
تِلقاء أنفسهم وإمَّا من تَلقيبِ غيرهم لهم بها.
لذا؛
فإنَّه لا يحسن أن يُفاجأ المُتعصِّبة من أتباعِ المذاهب، إذا قامَ الدَّليلُ على
أن أئمَّة المذاهب - رحمهم الله - جميعهم سلفيُّون - وما كانوا لِيُعرفوا بها وهم
كذلك - إلا لأنَّهم على قَدم المُصطفى عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وقدمِ أصحابهِ
رِضوان الله عليهم، وقد عُرفوا بها قبل نُشوءِ الحركاتِ والجماعاتِ الإسلاميَّة
المُعاصرة بقرونٍ، وحينَ كانت بلاد المُسلمين تَموجُ بفتَن الفِرَق.
فالأئمةُ
الأربعةُ - وغيرهُم من أمثالهم - هم سادةُ السَّلفيين، وأئمَّتهم، وهم أيضاً سادةُ
كلِّ من لا يُحبُّ أن يُنسب إلى هذه النِّسبةِ الشريفة، مِمَّن يَرى في عداوَة
أهلها واجباً شرعيّاً، وأدباً إسلامياً، وشرفاً دينيَّاً!
ومرَّة
أخرى أقول: كنت أودُّ أن لا أستعملَ كلمة (السَّلفية) هذه لما ذكرتُهُ آنفاً، أما
وقد فرضتْ نفسها، وصارت اصطلاحاً علميِّاً، أقرَّه التَّاريخ، ورضيته الأمَّة
كلُّها على مرِّ العصور، حتى صِرنا نَسمعُ من يَقول - وقوله غيرُ صواب -: «عقيدةُ
السَّلف أسلمُ، وعقيدةُ الخَلفِ أحكمُ»([7])
، فليس مِن بأسٍ أن نستعملها اصطلاحاً علميَّاً شمولياً مُحكماً.
ولماذا
لا يكون في استعمال نسبة الشافعيَّة أو الحنفيَّة مثلاً، ما يُشعرُ بالفُرقة،
ويكون ذلك في استعمال السَّلفية، في حين أن السَّلفية تَستوعبُ أئمةَ المذاهب
ومذاهِبهم، وتَستغرق أجيالاً وقروناً، بادَت أو لم تأتِ بعد، وتشمل الزَّمان
كلَّه، والأرضَ جميعاً.
إنَّ
هذا الكتابَ، وهو يَحكي تجربةً علميَّةً، ودعويَّةً، لا يُغفل الرَّدَّ على
المُفتريات، التي حَشدها بعض مَن كتَب عَن السَّلفية، طعناً ونَيْلاً، ولا بيانَ
بعض الأخطاءِ التي خالطها بعضُ السَّلفيين، ولا التَّعريف بالأسباب التي انخذل بها
الذين لم يَثبتوا على المنهج الأبلج الأبهج، وصاروا يحاولون التَّلفيق بين مَناهجَ
مُتعددَّة، ليُخرجوا من هذا التَّلفيق أضغاثاً، يكونُ منها جميعاً منهجٌ واحدٌ
(زَعموا)!!
ولا
بُدَّ من الإشارةِ، إلى أنَّ العِلم لم يُؤتَ بانتفاضٍ، أو انتقاصٍ، بمثلِ ما أوتي
من المتعالِمينَ المُتطاولينَ، وأنَّ منهج الحق هذا، يحتاج دعاةً علماءَ أتقياءَ،
أوفياءَ، أصفياءَ، أنقياءَ، لا يُغلَبون، ولا يُغالبون إلا بالحقِّ، وبالحقِّ
وحَده.
وشرفٌ
عظيمٌ أن يكونَ مِقوَلُ الحقِّ هو الأعلى، يسوقُ النَّاسَ إلى بابه، ويُغذيهم من
حِلابه، ويُمدهم من خَبءِ جِرابِه.
وليس
أصدق في الوصول إلى صوابِ الحُكم على أمرٍ ما، من التَّجربة الذاتيَّة،
المُتجردَةِ من عَنعَنات الرِّواية، وأسانيد الحكاية، تهديكَ إليه في غير انقطاع
ولا تحيُّرٍ.
وكلَّما
اتَّسعت دائرة التَّجربةِ - لتشملَ الأحداثَ، وشخوصَها، وأحوالَها، ومتعلَّقاتِها،
سواءٌ القريبة منها والبَعيدة، وكان لصاحب هذه التَّجربة تعلُّق دائمٌ بها، تمتدُّ
زماناً، يَكفي لاستحكام التَّجربةِ، واستيثاقها في نفسه - كانت (التَّجربةُ) أمكنَ
في الصَّواب، وأظهَر في الدَّلالةِ([8])
عليه، وأهدى سبيلاً في الانتهاء إليه.
وليس
يحسُن بصاحب مثل هذه التجربة، أن يضُمَّها إلى صَدره في حرص عليها، أن تنفَلِتَ
منه فيُبصرَ بها الآخرون، ولا أن يُكتِّمها في نفسه، خشيةً من أن يكون للنَّاسِ
علمٌ بها فَتشيعَ فيهم من قبل أن يَبْرءُوا سبيلها، ولا أن يَحوزوها حِرزاً
نَفيساً، لا يطَّلعُ عليه إلاَّ من ترسَّخَت في قلبه مودَّتهم وصُحبتُهم.
بل
إنَّ واجباً على صاحب هذه التَّجربة، أن يُرخيَ الحَبل لتجربته على غاربه، لتنطلقَ
في النَّاس، تُكلِّمهم أنَّهم في غَفلةٍ غافلةٍ عنها، ولو كانوا أرادوا الخيرَ
لأنفسهم لَهمُّوا بها مِن قبلُ.
وعليه
- أيضاً - أن يجعلَ من لسانِه آلةً أمينةً، تُلقي في أسماعهم حديثاً مُبرءاً من
وَشوَشات الصَّمت، وتَمتمات الوقْر، وأن لا يَضِنَّ بها على أحدٍ في الناس -
مُسلماً كان أم غيرَ مُسلم - لئلاَّ يكون لهم حجَّة عليها، أو على صاحبها، يَعرف
منها المسلم، أنَّ أصلَ هذه التجربة، هو دينه المُحكم، بعقيدته السَّمحةِ
الواضحةِ، وشريعته السَّهلة المُبيَّنة.
ويعرفُ
منها غير المسلم، أن أصلها هو الحقُّ الذي لُبِّسَ به عليه، فانصرف عنه غير آسفٍ
عليه، ولا راغبٍ فيه، ومضى عنه بعيداً بعيداً، يَبحث عن حق غيره، كنزهُ أحبارٌ من
كلِّ دينٍ، وهم يَتلونَ قول الله سبحانهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله
الإِسْلاَمُ} [سورة آل عمران: آية 19] وقوله: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ
دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [سورة آل عمران: آية 85].
إنها تجربةٌ ذاتيةٌ، تقلَّبتُ في
أعطافها في غضارة الشباب، وتضمَّختُ بِخَلوقِها الذَّكي منذ يفاعةِ العمر، ومشيت
في ركابها، أسمعُ حُداءَها النَّديَّ، ثلاثةَ عقودٍ ونيفاً، أملأُ منه جوانحَ
صدري، ويسري تطريبُه في أوصال جَسَدي، وتَهْمي منه عيوني شوقاً إلى لُقيا داعيهِ
الأوَّل.
عشتُ هذه التَّجربة بعقلي، علماً
ومعرفةً، وبقلبي نوراً وهدى، وبذاتي سلوكاً والتزاماً، فلا -والله- ما خَدَعتُها
ولا خَدَعتني (وحاشاها)، وما أضمرتُ لها إلاَّ الوفاء والحب، فأنالَتني من شرف ما
فيها ومن فيها، وسعيتُ إليها في علانيّةٍ شارقةٍ، فآذنتني بأحسن ما فيها ومَن فيها
(وما فيها إلا حَسَنٌ، وكلُّ من فيها على أحسَنِها فهو حسنٌ)، وتعفَّفتُ بها عن
نوال المُتكسِّبين والمُنيلين، فألقَت على منكبيَّ برداءِ القناعةِ المُوشَّى
بِعرف التَّقوى، وطهارة الغِنى، والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات([9]).
تجربةٌ ظاهرها هو باطنُها، ولفظُها هو
معناها، واسْمُها هو فَحواها، أرخَت ذيولها على جَمر البَغضاءِ ففثأته، ونفَثَت من
صَدرها الحاني على الجَهل فأذهَبته، وتجلَّلت سوادَ الأهواءِ العاشية بنورها
وضيائها ففرَّقتهُ.
امتدَّت
على القرون، بأجيالها، وركبانها، وأقيالها، وأوفرت لهم الجمَّ الغَفير من جَلالها
وكمالها وجمالها، وأنالت أيديَهم أعناقَ السُّحُب، فانهلَّت عليهم فضلاً من
مآقيها، وألقت إليهم بِبُردها المخموم بإحسانها.
تجربةٌ
سادت الدُّنيا بفِكرها، وعَقيدَتها، وعلمِها، وسَراتِها، وحِلَقِها، ومدارِسها،
ومَكتباتها، عَزيزةَ الجانب، بهيَةَ الطَّلعَةِ، نَديَّةَ الكفِّ، عفَّةَ
اللِّسانِ، مِعطاءَة الجَنانِ، طاهرَةَ الذَّيل، جَمَّة الوفاءِ، في غير استحياءٍ،
ولا استخفاءٍ، ولا مُخادعةٍ، وكيف لا...؟! وهي السُّـنَّة والكتابُ، وطابُ
اللُّباب، وجَرَع الصَّواب.
تجربة
من استشفى بها أسرعَ إليه الشِّفاء، ومَن رامَها حكمةً، وعصمةً، وشرفاً لم يُخطىء
الرَّوم، ومَن فاءَ إليها بعد فترةٍ وطولِ انقطاعٍ أوَى إلى جناحِه الفَيءُ.
وها
أنذا أضعُ هذه التجربةَ -التي تفضَّل الله بها عليَّ- هبةً غيرَ ممنونةٍ ولا
مَمنوعةٍ، وأقامني بها على الحقِّ الذي أراده سبحانَهُ لعبادِهِ، وأوثقني إليها في
رضا، وطواعية، وصدق - بين يَدَي «الأُمَّة»، لا أبغي بها حِوَلاً عن خَير
«أَمَّة»، قصُرت أمْ طالَت بي «الأُمَّة»([10]).
سائلاً
ربي سبحانه -أن يجعل مني مفتاحَ خيرٍ، مِغلاقَ شرٍ، مقبلاً بحق، معرضاً عن باطلٍ،
باذلاً لمعروفٍ ممسكاً عن منكرٍ، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ([11]).
أغاليطُ ظالمةٌ وتَمويهاتٌ




 المنتديات العامة
المنتديات العامة 






 ِ، وكظمِ الغيظ، والصَّفح الجَميل،
ِ، وكظمِ الغيظ، والصَّفح الجَميل،
